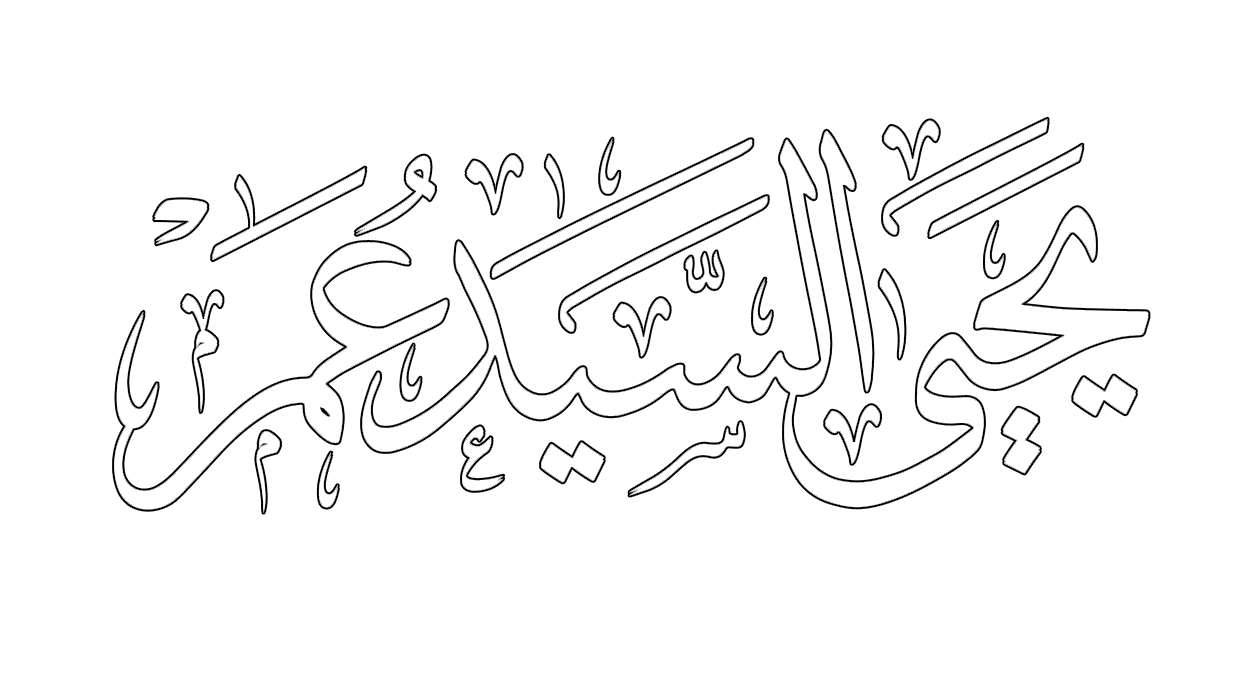
في خمسينيات القرن الماضي، كانت إيطاليا تنهض من بين أنقاض الحرب العالمية الثانية، وتحاول جاهدةً إعادة بناء اقتصادها. لكن في الجنوب الفقير، لم تكن الدولة حاضرةً بما يكفي. فبدَأ الناس في خلق نظامٍ اقتصاديّ مُوازٍ: وِرَش صغيرة، أعمال حِرَفِيَّة، بيع غير رسمي في الأسواق. هذا الاقتصاد غير المرئي ساعد الكثيرين على النجاة، لكنَّه في الوقت نفسه خلَق واقعاً اقتصادياً بلا ضرائب، بلا تنظيم، وبلا حماية. وهكذا وُلِد ما بات يُعْرَف اليوم بـ”اقتصاد الظِّلّ”.
اللافت أن الظاهرة ليست حِكْراً على الجنوب الإيطالي. فاليوم، يعيش العالَم العربي الظاهرة نفسها… ولكن على نطاق أوسع، وأحياناً بلا اعتراف رسمي بحجم المشكلة.
اقتصاد الظل تُعرِّفه منظمة العمل الدولية ILO باعتباره “كلّ نشاط اقتصادي يُمارَس خارج مظلة الدولة؛ فلا يُسجَّل في الضرائب، ولا يَخْضَع للضمان الاجتماعي، ولا تحكمه قوانين العمل”.
بدايةً من بائع الخضراوات في الشارع، إلى ورشة إصلاح السيارات غير المُرخَّصة، إلى متجر إلكتروني يُشغَّل من غرفة النوم. هذا الاقتصاد قد يبدو عشوائياً، لكنَّه مُنظَّم بطريقته الخاصة… ويَكْبُر كلما ضاقت الدولة على الرسميين. لكن السؤال الأخطر هو: كم نخسر من هذا الاقتصاد؟
في العالم العربي، لا يُقاس الاقتصاد فقط بما يَظهر في التقارير الرسمية أو يُدوَّن في دفاتر الضرائب. هناك اقتصاد آخر هائل، حيّ، لكنَّه غير مرئي، وهو اقتصاد الظل.
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، فإن هذا الاقتصاد يُشكِّل نسبة تقارب 68.6% من إجمالي العِمَالة في الدول العربية، أي: أن أكثر من ثلثي مَن يعملون في هذه المنطقة يمارسون وظائف لا تدخل ضمن القطاع الرسمي. نسبة تتجاوز المتوسط العالمي، وتعكس مدى اتساع هذا القطاع وتغلغله في تفاصيل الحياة اليومية.
لكنّ الأمر لا يقتصر على الأفراد. فحين ننظر إلى الناتج المحلي، نجد أنّ الاقتصاد غير الرسمي أو ما يُعرَف بـ”الإنتاج غير المُعلَن” يُمثِّل نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب مؤشر “شنيدر” للاقتصاد الموازي. أي: أنّ ما يقرب من ربع الاقتصاد يجري في الظل، بلا ضرائب، وبلا حماية، وبلا تنظيم.
في مصر وقبل جائحة كوفيد-19، تراوحت تقديرات حجم اقتصاد الظلّ بين 29.3% و50% من الناتج المحلي الإجمالي. أرقام تُظهر أن نصف الاقتصاد الوطني تقريباً قد لا يكون خاضعاً لأيّ إطار رقابيّ أو قانوني. هذا يعني أن ملايين المعاملات التجارية، والوِرَش، والمَحَال، والمِهَن الحِرَفِيَّة تُمارَس بعيداً عن أعين الدولة.
أما في المغرب فلا يختلف المشهد كثيراً. فوفق بيانات رسمية، يُشكِّل الاقتصاد غير الرسمي ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدَّى إلى تغييرات ملحوظة في مؤشرات النموّ، عبر شبكات موازية من العمل تتركّز فيها العِمَالة، وتتشكَّل فيها أسواقها الخاصة خارج النظام الضريبي.
بينما تُقدِّم تونس حالةً أخرى لا تَقِلّ تعقيداً؛ حيث تُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 43.9% من القوة العاملة هناك تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، أي ما يقارب نصف اليد العاملة التونسية. وهو رقم يعكس ليس فقط اتساع هذا الاقتصاد، بل أيضاً عُمْق اعتماده لدى شرائح واسعة من السكان.
بالطبع الخسارة لا تقف عند الأرقام. الدولة تخسر الضرائب، والمُواطِن يخسر الحماية، والاقتصاد يَخْسَر التوازن. ولكن دعونا نتساءل هنا: لماذا يختار الناس العمل في الظل؟
الجواب غالباً ليس التهرُّب أو الجَشَع، بل الهروب من التَّعقيد. بيئة الأعمال الرسمية في كثير من البلدان العربية شديدة التعقيد: رخصة واحدة قد تحتاج شهوراً، والضرائب غير واضحة أو مرتفعة، والتمويل مُتاح فقط للكبار أو المُقَرَّبين. في هذه الحالة، يصبح العمل خارج النظام خياراً منطقياً… وربما هو الخيار الوحيد.
لكن بقاء الوضع على ما هو عليه يحمل مخاطر هائلة. اقتصاد الظلّ، رغم أنه يُوفِّر فرص عمل، لا يُنْتِج نمواً مستداماً. فبدون بيانات رسمية، لا تستطيع الدولة التخطيط، ولا يمكن للبنوك تقديم القروض، ولا يمكن للتأمين أن يحمي العاملين. وفي الأزمات، كما رأينا خلال جائحة كورونا، يكون هؤلاء العاملون أول مَن يفقد دَخْله، وآخَر مَن يتلقَّى الدعم… هذا إن تلقَّاه أصلاً.
حل مشكلة اقتصاد الظل لا يكون بالقمع، بل بالفهم. دول عديدة واجهت الظاهرة بسياسات ذكية. رواندا مثلاً، أطلقت منصة رقمية موحدة لتسجيل المشاريع، تحت رعاية مجلس تنمية روندا RDB)) الذي تم إنشاؤه عام 2008م، ما سهَّل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأسيس الرسمي. وزاد عدد الأعمال المسجلة رسمياً مما وضَع رواندا كثاني أسرع اقتصاد نموّاً في إفريقيا بنسبة نمو 9.9%.
الحوافز أفضل من العقوبات، وتقنين اقتصاد الظل لا يعني تحويله إلى نموذج بيروقراطي خانق، بل احتضانه بالتَّدريج، وتقديم إعفاءات ضريبية مُؤقَّتة، دَعْم تمويلي للمشروعات الصغيرة، تسجيل مبسَّط عبر التطبيقات، ونظام حماية اجتماعية يناسب قدراتهم.
الخلاصة: نحن لا نتحدَّث عن اقتصادٍ مُوازٍ… بل عن نصف الاقتصاد الحقيقي. اقتصاد الظل ليس ثغرة في النظام الاقتصادي، بل نتاج فشل النظام في أن يكون شاملاً وعادلاً ومرناً. السؤال لم يعد: كيف نُلاحقهم؟ بل: لماذا لَمْ نحتضنهم من البداية؟
نحن لا نخسر فقط ضرائب… بل نخسر طاقات بشرية، أفكاراً إبداعية، وشبكة أمان اجتماعي كان يمكن أن تشمل الجميع.