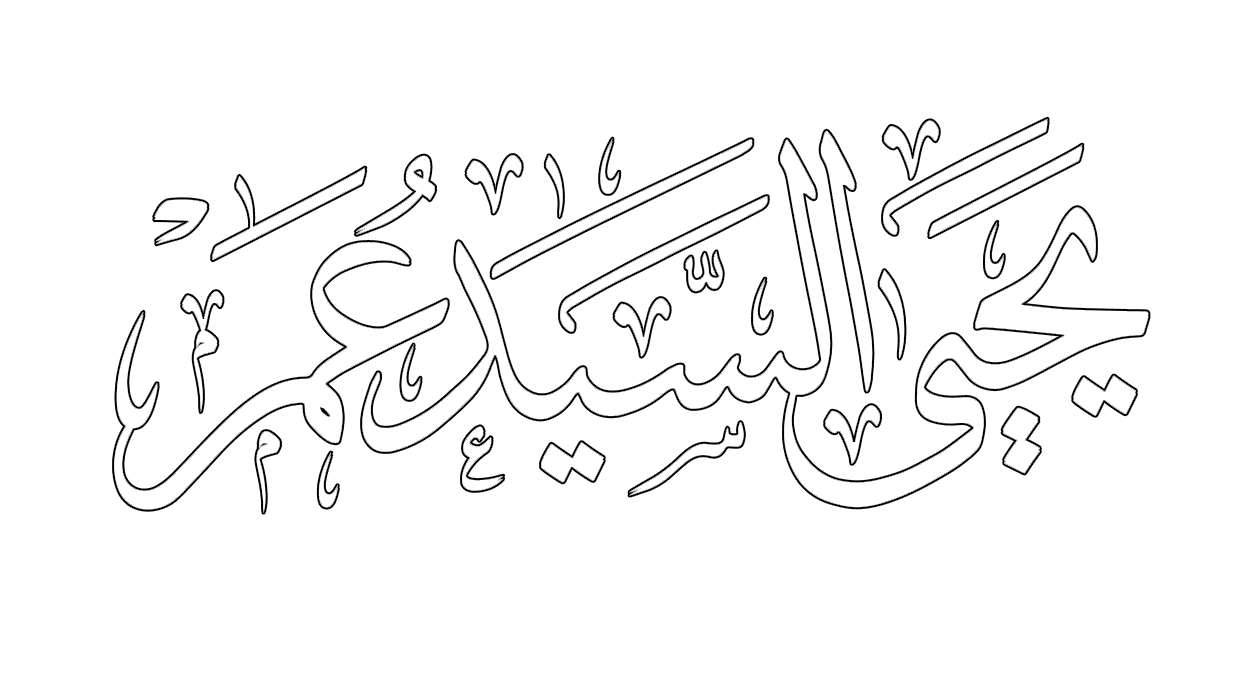
إن “القيمة المضافة” مصطلح اقتصادي بحت يشير للقيمة المادية الناتجة عن التغيير الذي يطرأ على مادة ما نتيجة خضوعها للعملية الإنتاجية. مثل: تحويل قصب السكر من نبات إلى سكر محلّى. فهي الفرق بين سعر شراء المواد الخام (القصب) اللازمة للإنتاج وبين سعر بيعها كمنتج نهائي (السكر) للمستهلك. والسؤال هنا: كيف تشكّل “القيمة المضافة” الأمان السياسي للدول الكبرى؟
في البداية يمكن تعريفها تجارياً أو في مجال الأعمال بأنها الفرق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج. واقتصادياً هي مجموع ربح الوحدة الواحدة أو تكلفة استهلاك الوحدة. وبعيداً عن مجال الاقتصاد فإن القيمة المضافة هي الميزة الإضافية التي تتجاوز التوقعات وتقدم شيئاً إضافياً أكثر.
في الحقيقة تتعدَّد أنشطة القيمة المضافة التي يمكن لشركات الأعمال إدراجها في خططها التنفيذية والتسويقية. فمثلاً يمكن إضافة القيمة من خلال تحسين جودة المنتج أو الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمستهلك في توقيت مثالي. مع توفير مزايا إضافية مثل خدمات ما بعد البيع والدعم الأفضل للعملاء وغيرها.
وتتجاوز أهميتها مستوى الشركات ومؤسسات الأعمال لتشمل اقتصاد الدول ككل. فإجمالي القيمة المضافةGVA) ) يختص بقياس الناتج المحلي الإجمالي للدولة. من خلال حساب مساهمة مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص في إجمالي الناتج المحلي. أي أنها مؤشر أساسي لوضع الاقتصاد الكلي للدولة.
في إطار العلاقات الدولية الراهنة بين القوى العالمية والذي بدأت ملامحه تتحدد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومع مطلع القرن الحادي والعشرين. تبدلت معايير الصراع بين الأقطاب الدولية الفاعلة ليصبح الاقتصاد محور التنافس السياسي بين الدول بدلاً من القوى العسكرية والمبادئ الأيديولوجية.
التنافس السياسي العالمي “الجديد” ساهم في تنامي دور العوامل الاقتصادية. فأصبحت مرتكز التفاعلات الدولية فيما بعد. ليتحول محور الصراع الدولي -ما بعد الحرب الباردة- من خانة “القوة العسكرية” إلى “القوى الناعمة” الأقل تكلفةً والأشد تأثيراً. وذلك عن طريق التفوق الاقتصادي والتحكم بالتكنولوجيا.
من جهة أخرى فإن الرغبة في التفوق الاقتصادي أكسب مصطلح “القيمة المضافة” الكثير من الأهمية عالميّاً. حيث أصبحت الدول الكبرى تلهث وراء المواد الأولية الثمينة للحصول عليها بثمن بخس. ثم إدراجها في عمليات الإنتاج وطرحها مجدداً في الأسواق النامية بأثمان مرتفعة والاستفادة من فارق الأسعار.
وفي الوقت نفسه فإن الصراع الاقتصادي الجديد كرّس لمزيد من علاقات التبعيّة بين الاقتصادات القوية والضعيفة. فالدول الكبرى تفوز بثروات الدول النامية من المواد الخام (النفط والغاز الطبيعي…) بأسعار زهيدة لاستخدامها في الإنتاج. ثم تعيد تصدير منتجاتها بأسعار مرتفعة للأسواق النامية محققةً قيمة مضافة كبرى.
كما أن القيمة المضافة الكبرى المتحققة لاقتصادات الدول المتقدمة جعلتها المصدر الرئيس لرؤوس الأموال وعناصر الصناعة. لذلك أصبحت هي الفائز بمركز الدائن بسيطرتها شبه الكاملة على مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي- صندوق النقد…..). فتفرض ضوابطها على الدول النامية لضمان استمرار تفوقها الاقتصادي.
لكن تحوّل السوق العالمية لسوق مفتوحة بإسقاط حواجز الزمان والمكان أوجد نوعاً جديداً من الاستعمار “الاستعمار الاقتصادي“. حيث تسعى الدول الكبرى لفرض منتجاتها وخدماتها. ما أشعل التنافس القوي بين الشركات التابعة لها وفرض الاهتمام بامتلاك ميزة تنافسية تتعلق غالباً بالسعر/الإنتاجية/ الجودة.
إن التحول من اقتصاد ضعيف لآخر قوي يتطلب تحقيق النمو والانتشار وزيادرة القدرة الاقتصادية. من خلال مواكبة السياسات التجارية والالتفات لاقتصاديات السوق والتحرر الخارجي والسيطرة على التجارة الخارجية. ما يتطلب رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والمنافسة وتوفير قيمة مضافة متفردة.
النموذج الياباني والتفوق التكنولوجي والاقتصادي بعد هزيمة عسكرية مدوية في نهاية الحرب العالمية الثانية. أثبت جدوى اعتماد سياسات “القيمة المضافة” في التحول من دولة منهارة تماماً إلى قوة اقتصادية دولية لا يُستهان بها. واليوم أصبح المنتج الياباني خارج المنافسة ويحظى بالتقدير العالمي.
بعد الحرب اتجه اليابانيون لبناء قدراتهم الصناعية الذاتية. فبدأوا باستيراد التقنية واستيعابها ثم امتلاكها وبناء التقنية ذاتياً وتصديرها. فاستطاعوا الاستفادة من العلم والمعرفة وتطويرها وصولاً لبناء القدرة الذاتية في الصناعة المتطورة. وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية والقيمة المضافة.
في النهاية إن السعي وراء هذه القيمة أدى لزيادة درجة التنافسية في الاقتصاد العالمي. وإزالة/تخفيف العوائق في مستوى التدفقات الدولية السلعية والمالية. ونشوء أسواق عالمية للسلع والخدمات المختلفة تتصارع فيه البلاد على إضافة قيمة مميزة لمنتجاتها لا يقدمها الآخر. ما يصبّ دون شك في صالح المستهلك.