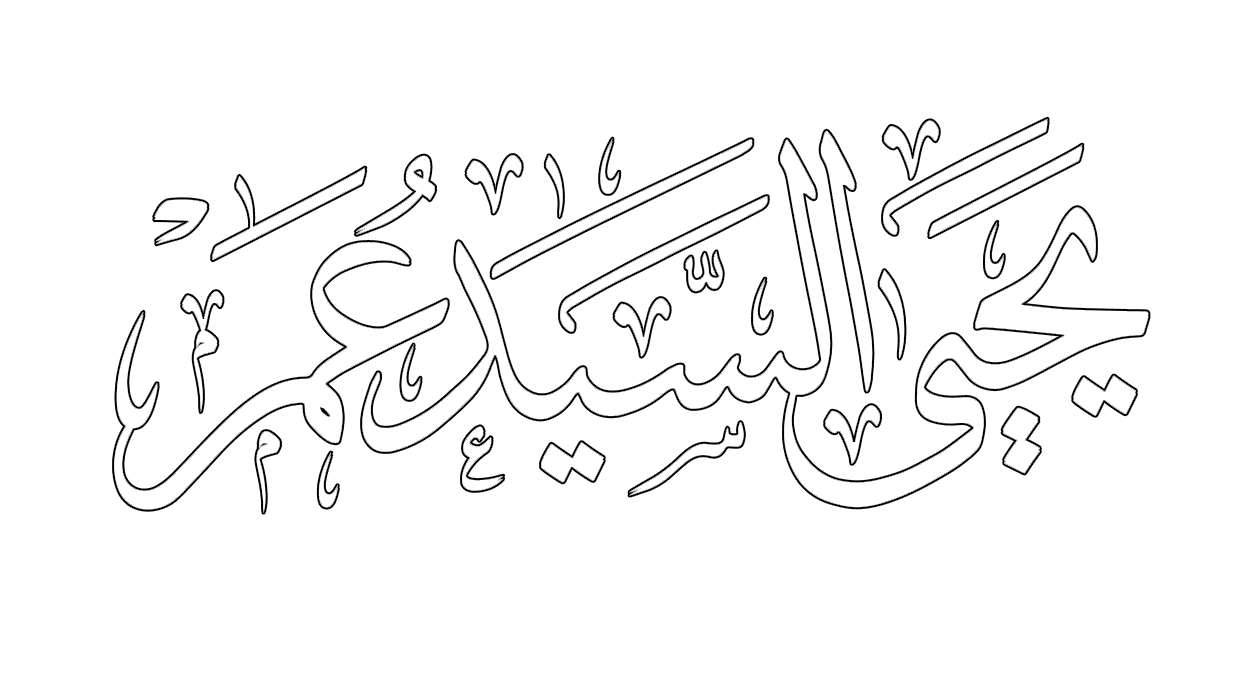
في منتصف القرن العشرين، وُلِدَ نظام اقتصادي عالَمي تهيمن عليه القوى الغربية؛ الولايات المتحدة صاغت اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتجعل من الدولار الأمريكي محور النظام النقدي العالمي.
لعقودٍ، ظلت الكلمة العليا للاقتصاد الغربي. لكن مع حلول القرن الحادي والعشرين، ظهرت ملامح جديدة. قوًى صاعدة من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا بدأت تتحرّك على الساحة الدولية: الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، وروسيا، وهي المجموعة التي ستُعرف لاحقاً باسم “بريكس”.
بداية رمزية لمجموعة بريكس
كانت البداية رمزية، لكنّ الزمن منَحها زخماً، واليوم، ومع توسُّعها، باتت تُمثِّل ملامح نظام عالمي جديد.
في الأول من يناير 2024، انضمت مصر، إثيوبيا، إيران، والإمارات رسمياً إلى التكتل، ثم لحقت بها إندونيسيا في يناير 2025. وبذلك، تحوّلت “بريكس” إلى “بريكس+”، وبدأت الأرقام تتحدث بلغة مغايرة.
إعادة تشكيل النظام المالي العالمي
وفقاً لصندوق النقد الدولي، سجّلت المجموعة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% في عام 2025، مدفوعة بقوة من اقتصادات ناشئة كالهند، والصين، وإثيوبيا. ولم تَعُد المسألة محصورة في النموّ فقط، بل في الثِّقل الإستراتيجي؛ فبحسب آخر التقارير، باتت دول “بريكس+” تُمثّل 45% من سكان العالم، وتنتج أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند حسابه وفق تعادل القوة الشرائية، وتضخّ نحو 30% من إنتاج النفط عالمياً.
في مواجهة الهيمنة الغربية، سعت “بريكس” إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، عبر تقليل الاعتماد على الدولار، وتأسيس بدائل مثل بنك التنمية الجديد (NDB)، وصندوق الاحتياطي الطارئ (CRA). والتحول الذي حصل أن رؤوس الأموال لم تَعُدْ حِكْراً على مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
بين الطموح والتحديات
الطموح واضح: نظام أكثر توازناً وعدالة. لكنّ الطموح لا يعني الانسجام؛ بينما تُفَضِّل دول كالهند والبرازيل إبقاء مسافة مَرِنَة مع الغرب، تدفع الصين وروسيا نحو مواجهة مباشرة، مما يضع “بريكس+” أمام تحدٍّ داخلي: هل تستطيع تنسيق سياساتها رغم التباينات السياسية والاقتصادية بين أعضائها؟
التجارة بين دول المجموعة كانت إحدى مؤشرات التقدُّم الفعلي. بين عامي 2017 و2022، ارتفعت التجارة البينية بنسبة 56%، لتصل إلى أكثر من 614 مليار دولار. وبدأت بعض الدول تتَّجه نحو التخلُّص التدريجي من هيمنة الدولار، عبر التسويات بالعملات المحلية. ففي عام 2021، أشارت تقارير إلى أن ربع المبادلات التجارية بين دول “بريكس” أصبحت تتم بالعملات الوطنية. يعني الأمر لم يعد نظرياً، بل دخل حيّز التنفيذ الفعلي.
مع التوسع، ازدادت الحصة النسبية للمجموعة من الموارد الحيوية. وهنا أصبحت “بريكس+” مسؤولة عن 43.1% من إنتاج النفط العالمي، وتملك 44% من احتياطياته، كما تنتج 35.5% من الغاز الطبيعي ولديها أكثر من نصف احتياطياته عالمياً. بينما تؤكد البيانات أن المجموعة تحوز نحو 40% من الاحتياطات المثبتة من النفط على مستوى العالم، وهي أرقام تقلب موازين الطاقة التي لطالما كانت إحدى أدوات الهيمنة الغربية.
على صعيد القوة الاقتصادية الكلية، التحوُّل أصبح ملموساً. حصة “بريكس+” من الناتج العالمي تجاوزت مجموعة السبع G7 من حيث تعادل القوة الشرائية منذ عام 2018، وبلغت الفجوة ذروتها عام 2024، إذ بلغت حصة “بريكس+” 35% مقابل 30% فقط لـ G7. هذا التحوُّل لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة انضمام دول كإيران، مصر، إثيوبيا، والإمارات التي عزَّزت من حجم الأسواق والموارد البشرية والطاقة داخل التكتل.
تأسيس نظام متعدد الأقطاب
الصورة الكلية تقول شيئاً واضحاً: النظام العالمي لم يعد قائماً على القطب الواحد. الصعود التدريجي لبريكس يُؤسِّس لنظام متعدد الأقطاب، يخلق توازنات جديدة ويكسر احتكار القرار الاقتصادي.
لكنّ هذا التحول يبقى هشّاً إذا لم تتجاوز المجموعة تناقضاتها الداخلية. التحديات لا تكمن فقط في الخارج، بل في الداخل أيضاً: تباينات جيوسياسية، اختلافات في نظم الحكم، وتضارب مصالح في ملفات الطاقة والحدود والتجارة.
المعركة لم تَعُد بين دول فقط، بل بين رؤى للعالم: هل ستبقى المؤسسات المالية والسياسية بيد الغرب؟ أم أن الجنوب العالمي سيُحْسِن استثمار لحظته التاريخية؟ نجاح “بريكس+” يتوقف على تحويل الأفكار إلى سياسات، والبيانات إلى نفوذ، والشعارات إلى مؤسسات فاعلة.
قد تكون “بريكس+” اليوم قوة اقتصادية واعدة، لكنّ المستقبل وحده سيُحدّد إن كانت ستنجح في إعادة كتابة قواعد اللعبة، أم أنها ستظل عنواناً لطموحٍ لم يكتمل.