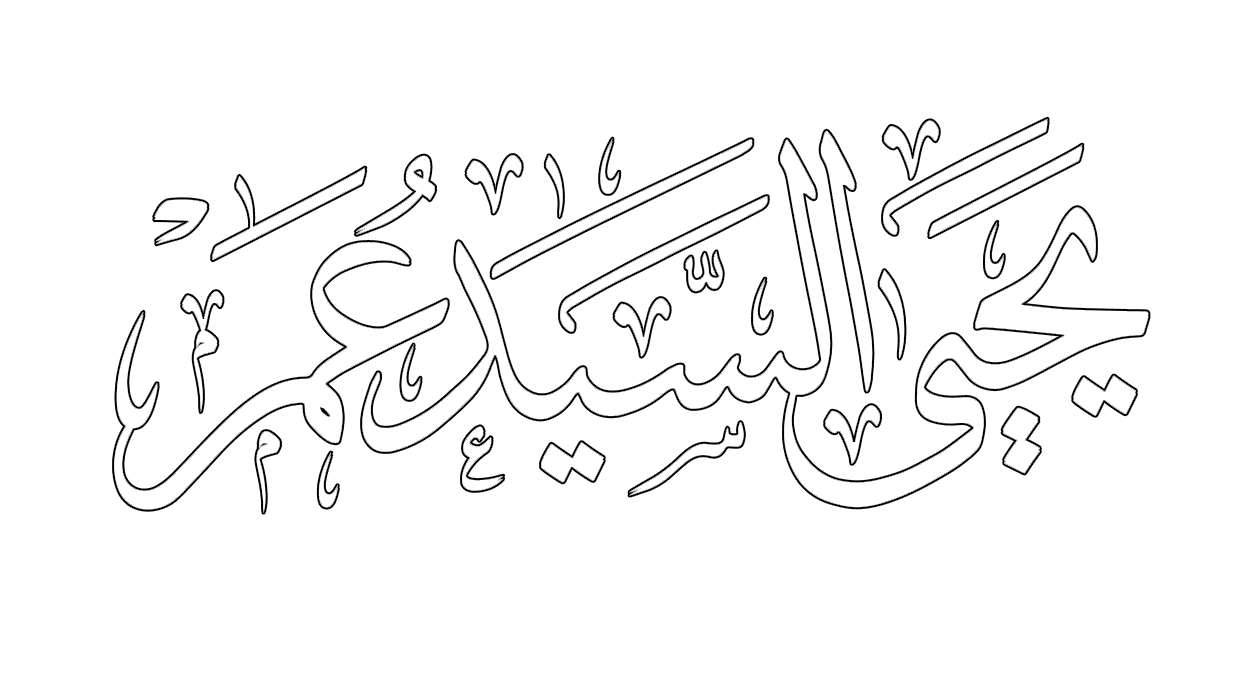
في عام 1553م، وقف السلطان سليمان القانوني على تلَّة تطِلّ على نهر بردى في دمشق، وأشار إلى الأرض التي كانت في يوم من الأيام قصرًا للسلطان الظاهر بيبرس، وأمر ببناء تكية بهذا المكان.
ومن يومها وُلِدَتْ التكية السليمانية، والتي تُعدّ واحدةً من أجمل ما تركه المعماري العثماني “معمار سنان”. كانت فكرة الوقف وقتها بسيطة وعظيمة في آنٍ واحد؛ أن يُحْبَس المال ليبقى نَفْعه بعد صاحبه، فيأكل الجائع، وينام المسافر، ويتعلم الفقير.
تحوَّلت التكية إلى قلب نابض لدمشق. في كل ركن كانت تُوزَّع وجبات الطعام اليومية، وفي كل زاوية يجلس الفقراء والطلاب، وبدا الوقف كما يجب أن يكون: رحمة جارية تمشي بين الناس.
إشكاليات كبيرة في إدارة الأوقاف
اليوم تُوجد إشكاليات كبيرة في إدارة الأوقاف في معظم الدول الإسلامية، لم يَعُد للأوقاف إدارتها الخاصة، بل أصبحت تحت إشراف الحكومات، ولم يَعُد للوقف مكانته كما كان من قبل.
من أهمّ الإشكاليات التي تُواجِه نظام الوقف اليوم هو التعدِّي عليه، أو نزع ملكيته؛ بحجة إقامة مشاريع تنموية، مثل: شقّ طرق، فأحيانًا يكون الوقف ضمن مخطط طريق أو غيره من المشروعات، وهنا تبدأ المعادلة الصعبة: كيف نحافظ على الوقف، وفي الوقت نفسه نشقّ الطريق أو نُنفّذ المشروع؟
في سوريا اليوم، أصبحت التكية السليمانية تحت إشراف وزارة الأوقاف، لكنها فقدت كثيرًا من رسالتها الاجتماعية، مبانيها ما تزال قائمة، لكنّ الحياة فيها أصبحت ساكنة… جزء منها تحوَّل إلى سوق للحِرَف التقليدية ومتحف صغير، وجزء آخر مُغلَق بحجة “الحفاظ والترميم”.
أما في مصر، فكانت الأوقاف يومًا من الأيام أحد أعمدة الحياة العامة، خاصةً في العصور المملوكية والعثمانية، وصلت الأوقاف في مصر في بعض الأوقات إلى أن 40% من الأراضي الزراعية كانت وقفًا، والأوقاف كانت تُموِّل التعليم في الأزهر، والمراكز الصحية، وتَكْفُل الطعام للفقراء في التكايا، فضلًا عن إمدادات المياه ورعاية الحيوانات.
لكن بعد صدور قانون تنظيم الأوقاف عام 1952، تحوَّلت الإدارة إلى جهاز مركزي حكومي؛ ما أدَّى إلى تراجُع العائد وضَعْف الدور الاجتماعي.
نموذج واضح على هذا هو وقف السلطان “قنصوه الغوري” في القاهرة، الذي كان يشمل كثيرًا من الأنشطة الاجتماعية في القرن السادس عشر، واليوم يعاني من الإهمال والضعف، رغم موقعه الحيوي.
المفارقة هنا، أن الأماكن التي كانت ملاذًا للمحتاجين يومًا ما، أصبحت اليوم مزارًا سياحيًّا أكثر من كونه بيتًا للرحمة. التكية السليمانية وغيرها، ما زالت شاهدة على زمن كانت فيه الأوقاف تصنع الحياة.
كيف فَقَد الوقف رمزيته؟
السؤال هنا: كيف فقد الوقف رمزيته؟ وكيف أعادت دول أخرى -مثل تركيا وأمريكا- إحياءَه بعقل جديد وروح قديمة؟
في التاريخ، -كما نوضح في كتاب “الوقف وأثره على الاقتصاد والمجتمع”-، كان للوقف شروط دقيقة لضمان استمراريته وطابعه الخيري، منها: عدم بيع الأصل الوقفي، وثبات صرف الريع في مساعدة المجتمع.
هنا يظهر جوهر الوقف، وهو تحقيق “العدالة”، بأن يمتدّ نَفْع المال بعد موت صاحبه ليعمّ المجتمع؛ وهو ما يجعل الوقف جزءًا من مفهوم الاستخلاف لا التملك. لكنّ تدخُّل بعض الدول بإدارات بيروقراطية أو تغييرات قانونية عطَّلت هذه الشروط؛ مما أدَّى إلى فقدان فعاليته، وأحيانًا كانت الإدارات تستحوذ على الأوقاف.
وعلى الرغم من هذه الإشكاليات، نجحت دول أخرى مثل تركيا وأمريكا في تطوير هذه الشروط وإدارة الأوقاف بذكاء.
التجربة التركية في إدارة الوقف
بَعْد عقود من التراجع الذي أصاب الأوقاف في العالم الإسلامي، أعادت الدولة التركية إحياء هذا النظام بذكاء إداري واقتصادي، وحافظت على أوقاف الناس، وظل الوقف يؤدّي الدور المطلوب.
اليوم تُشرف المديرية العامة للأوقاف على عشرات الآلاف من الأوقاف، تشمل مطابخ خيرية تُقدّم الطعام بالمجان للمحتاجين، ومشروعات إسكان وتعليم وصحة؛ بحيث تُحقِّق أهدافها المطلوبة دون أن يتراجع دور الوقف.
اللافت أن تركيا لم تكتفِ بإدارة الأوقاف الخيرية فقط، بل فعَّلت مفهوم الوقف الجامعي، فصار للجامعات وقفيات خاصة تُموِّل البحث العلمي والتعليم، مثل جامعة صباح الدين زعيم وجامعة السلطان محمد الفاتح.
لكن، هل هذا يعني أن تركيا الحديثة لم تُواجِه صعوبات في حفظ الوقف الموجود منذ عصور؟!
بالطبع هناك صعوبات واجهتها الإدارة الحديثة في تركيا، ومنها: ضياع حُجَج الأوقاف؛ فكثير من الأوقاف القديمة لم يكن لها سجلات، وبعضها مفقود بين الأوراق، لذلك قامت الحكومة بوضع آلاف الأوقاف التاريخية تحت إدارتها من أجل استفادة المجتمع منها.
مع التطوُّر التكنولوجي، تَغيَّرت شَكْل الحاجات المجتمعية، وأصبح من الضروري أن يُواكِب الوقف متطلبات العصر. فاليوم توجد تجارب عديدة مثل الوقف العلمي الرقمي، وهذا موجود في أكثر من دولة، وكذلك “الوقف الأخضر” الذي يُخصِّص أموالًا لحماية البيئة والطاقة النظيفة. وهذا يعني أن الوقف لم يَعُد فقط يُوفِّر الطعام أو الملابس، وإعانة طلاب العلم، بل أصبح عِلمًا وطاقة ومعرفة متطورة.
التجربة الأمريكية في إدارة الوقف
في التجربة الأمريكية لم يَعُد الوقف مجرد صدقات، بل انتهى به الأمر ليصبح مؤسسة اقتصادية حقيقية يتبنَّى تنمية مستدامة.
الإحصاءات تذكر عشرات آلاف المؤسسات الوقفية بأصول تتجاوز 550 مليار دولار، وهذا الرقم ليس بسيطًا. ومن رِيع هذه المشاريع، يُصرَف سنويًّا حوالي 30 مليار دولار على التعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية.
هنا يتضح الفرق، إدارة الوقف ليست فقط تشريع قوانين أو سنّ قواعد تنظيمية، بل عقلية استثمارية واعية. ومن تلك النماذج مثلًا: مؤسسة كارنيجي التي أسَّسها أندرو كارنيجي عام 1906م لدعم التعليم، ومؤسسة فورد الوقفية التي حوَّل مُؤسِّسها 90% من أسهم شركته الخاصة لوقف خيري، هذه المؤسسات لم تكن “تبرُّعات موسمية”، بل كانت مشاريع تنموية على المدى البعيد.
الوقف في الإسلام منظومة تُحرّك الحياة
من يقرأ تاريخ الوقف في الحضارة الإسلامية، يُدرك أن الموضوع ليس فقط توجُّهات دينية قصيرة الأمد، بل كانت منظومة تُحرّك الحياة كلها، المدارس، والمستشفيات، والطرق، وأسبلة الماء بالشوارع، أغلبها كان من أموال الوقف.
باختصار، الوقف كان النبض الاجتماعي الذي يجعل المجتمع يعيش بتكافل حقيقي، دون انتظار دور الدولة. ومن هنا نفهم أن الوقف في الإسلام كان شكلًا مبتكرًا من أشكال “العدالة الاجتماعية”.
ولكنّ أوضاع الوقف اليوم تُواجِه إشكاليات كبيرة، وأصبحت مُعقَّدة بسبب التغيُّرات الكبيرة التي حدثت في إدارة الأوقاف على مدى السنوات الماضية.