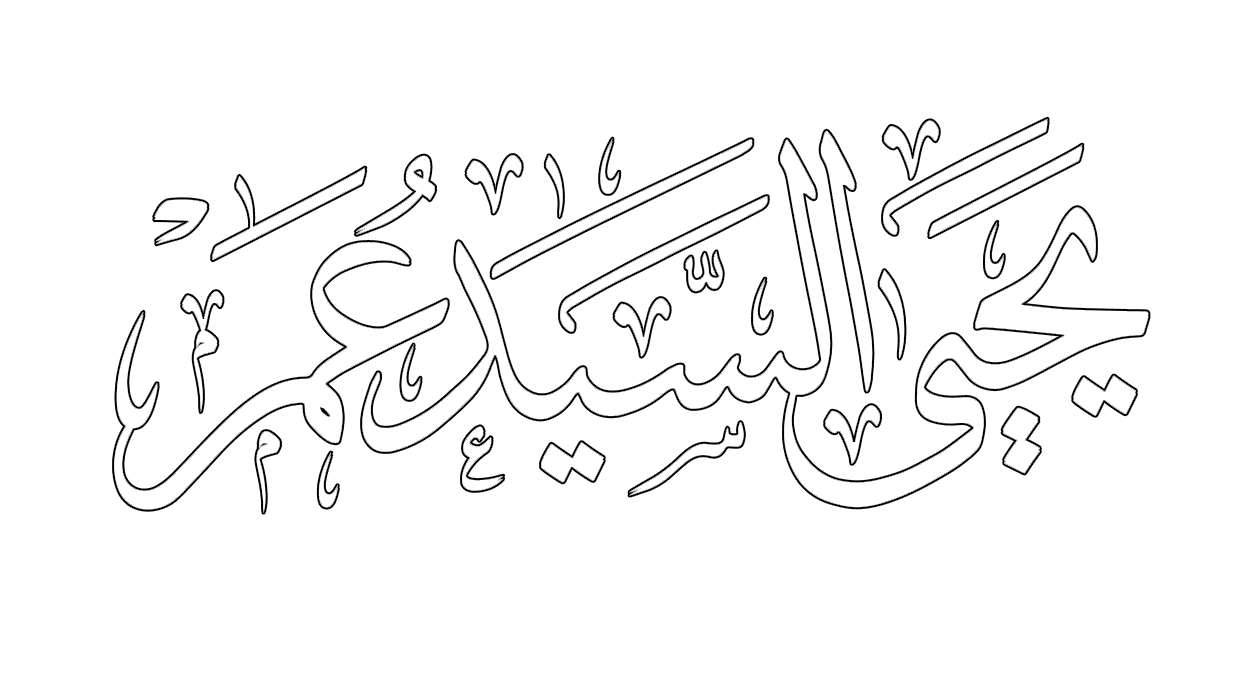
في عام 1845، كتب الاقتصادي الفرنسي “فريدريك باستيا” عريضةً ساخرةً باسم “صانعي الشموع”، يُطالب فيها الدولة بحَظْر دخول ضوء الشمس؛ لأنها تَضُرّ بصناعتهم وتُنافسهم دون تكلفةٍ.
لم يكن هدفُه تمرير قانون، بل فَضْح عبثية السياسات الحمائية، التي تُطالِب بحماية الصناعات الضعيفة، ولو على حساب المنطق، كما سَخِر من الرُّسوم الجمركية الحمائية؛ لأنَّ تدخُّل الدولة السريع يُشبه توزيع الثروة بالقانون، في عبثٍ لا يقلُّ غرابةً عن العريضة نفسها.
اليوم، وبعد قرنين من الزمن، يعود منطق “إغلاق النوافذ” في ثوبٍ أكثر حدة وقوة. ولكنَّه هذه المرة لا يُقَدّم في كُتَيِّب ساخر، بل يُوقَّع بمرسومٍ رئاسيٍّ من أقوى رجلٍ في العالم. فعندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض أعاد معه فلسفة اقتصادية مفادها: “إذا كانت هناك مُنافَسَة، فلْنَمْنَعها بالتعرفة الجمركية”. وكانت النتيجة أن انفجرت واحدة من أعنف الحروب التجارية في التاريخ الحديث، استهدفت الصين أولاً، ثم امتدت لتَطَال الحلفاء قبل الخصوم.
تبدو الرسوم كدعم للمُصَنِّع المحلِّي، لكنَّها في الواقع ضريبة غير مباشرة على المستهلك. كلّ ثمَن إضافيّ يدفعه المُواطِن يُقوِّض قُدْرته الشرائية، بينما تتحوَّل الصناعات الأمريكية إلى خطوط إنتاج أضعف، بتكلفة أعلى، وربح أقل.
ويبدو أنّ الأثَر المباشِر لسياسة ترامب يَذْهب بعيدًا عن المُصنِّع المحلي؛ حيث تقع الرسوم غالبًا في منتصف سلسلة التوريد، ممَّا يُؤدِّي إلى رَفْع الأسعار النهائية لسلع مثل الإلكترونيات والسيارات؛ لأن المُستهلِك في النهاية هو الذي يدفع، وليس المُصَنِّع.
وهذه السياسة ليست جديدة تاريخيًّا؛ ففي الثمانينيات، انقلبتْ إصلاحات غورباتشوف الداخلية على النظام السوفييتي نفسه؛ حيث أثبتت تجربة إعادة الهيكلة والشفافية، أنَّ الإصلاح بالتدخُّل قد يَقْلِب النظام رأسًا على عقب. فتحت هذه التغييرات أبواب الفوضى، وانتهتْ بانهيارٍ شاملٍ للنظام السوفييتي.
تدخُّل الدولة عبر الحماية الجمركية، يُضْعِف المبادئ الحُرَّة للسوق. فَرْض الرسوم الجمركية أضرَّ بسلاسل الإمداد عالميًّا، وقَلَّل من الثقة بالدولار كعُمْلة احتياط عالمية، ودفَع رؤوس الأموال للنزوح إلى أسواقٍ بديلةٍ. كما كان تأثيرها واضحًا في رَدّ فِعْل الأسواق خلال اجتماع البريكس الأخير؛ حيث أدَّت هذه الإجراءات إلى زيادة تكلفة السِّلع، والضَّغط على المستهلكين، ما خَلَق ضغوطًا تضخُّمية وخفضًا في النموّ الحقيقي.
ترامب لا يبدو أنه يسعى لهَدْم مؤسسات الدولة، لكنَّه في سَعْيه لإعادة بناء أمريكا أولًا، قد يَدْفعها نحو مسارٍ محفوفٍ بالمخاطر. إطلاق الحمائية باسم القومية الاقتصادية قد يبدو حلًّا سريعًا وذكيًّا، لكنَّه في الحقيقة حلّ قصير النظر، ويحمل بذورًا لحالةٍ هشَّة لا عودة منها، تمامًا كما حدث مع غورباتشوف في الاتحاد السوفييتي. إذًا لم تَعُد المسألة مسألة حمائية فقط، فالقضية أكبر من شخص أو دورة مالية، بل نظام اقتصاديّ عالَمي متخلخل. والسؤال الآن: إذا استمر هذا المسار الحمائي، هل تقاوم أمريكا الانكماش أم تنزلق نحو التفكك؟
خلاصة القول: التاريخ علَّمنا أن تدخُّل الدولة المُكثَّف في السوق قد يُؤدِّي إلى زلزال داخلي مُغاير لقَصْد الإصلاح، وما يبدو كحركة اقتصادية وطنية، قد يكون بدايات تفكُّك عميق. لكنَّ إلى أين ستصل أمريكا