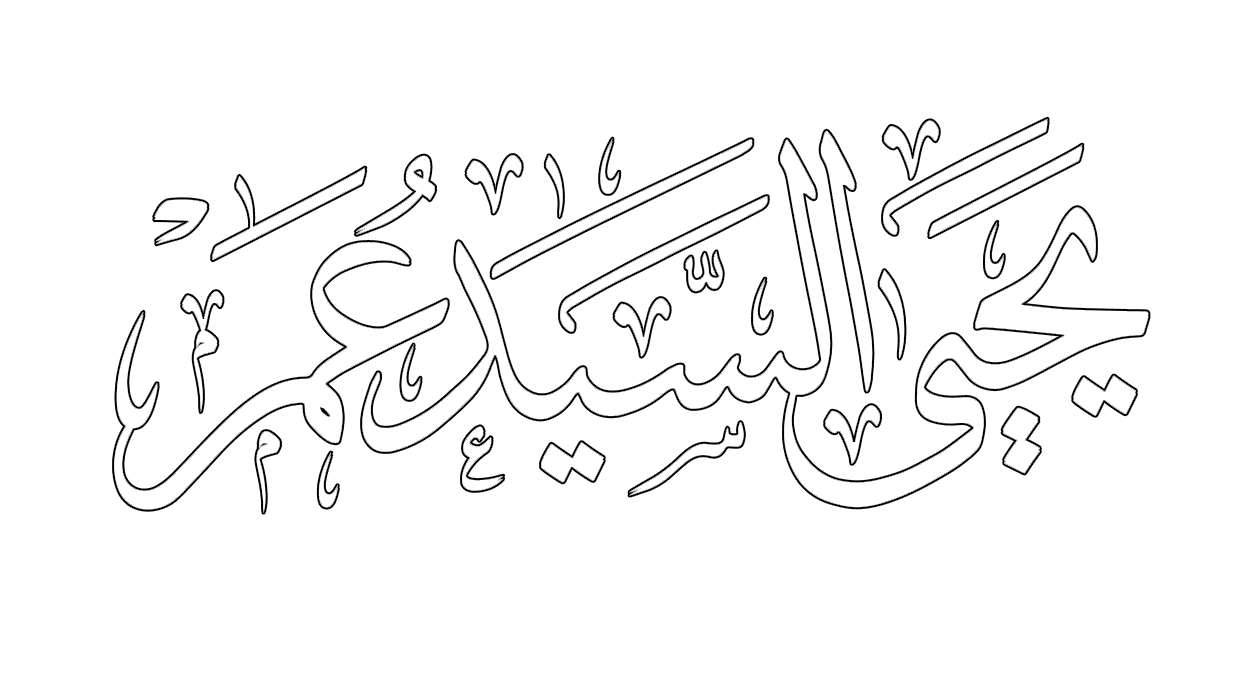
في عام 2010، استيقظ العالَم على خبرٍ بَدَا وكأنه مشهد من أفلام التجسُّس. فيروس ضرب منشآت نووية إيرانية، ولم يكتفِ بتعطيلها، بل فَعَل ذلك بدهاء مُذْهِل وهو فيروس يُدْعى “Stuxnet” كان يتحكّم بأجهزة الطرد المركزي، ويجعلها تنفجر من الداخل، دون أن يُخلِّف أثراً مباشراً. لا طائرات، لا صواريخ، لا قنابل… فقط شفرة برمجية صغيرة. ومن هذه اللحظة، تَغيَّر تعريف الحروب.
الحروب الرقمية
الحروب لم تَعُد مقتصرةً على الدبابات والمدافع، بل باتت تُدار بالأكواد والأوامر الرقمية. والجندي لم يَعُد يرتدي الخوذة، بل صار يجلس خلف شاشة. العالَم دخَل زمن الحروب الإلكترونية، زمن الخطر الخفي، الذي يشلّ الاقتصاد ويسرق بيانات بمليارات الدولارات… وكل ذلك من وراء آلاف الكيلومترات.
التطور التكنولوجي السريع خلق فجوة ضخمة، بين قدرة الآلة على التدمير، وقدرة الدول على حماية نفسها. الهجوم السيبراني أصبح أسرع من أيّ حربٍ تقليدية، وأصعب في التَّتبُّع، وأسهل في الإنكار. شخص واحد، جالس بغُرفة مظلمة، قادر على اختراق وزارة مالية، أو شلّ مؤسسة اتصالات. وهنا لم يَعُد التهديد أمنياً فقط، بل اقتصادياً من الطراز الرفيع.
من أبرز الأمثلة أنه لما تعرَّضَت شركة “Sony Pictures” لهجومٍ سيبرانيّ عام 2014، بسبب فيلم ساخر عن زعيم كوريا الشمالية، كانت الخسائر فادحة. ما كانت القصة مجرّد تعطُّل بيانات، بل خسائر مالية وصلت إلى 35 مليون دولار، وتسريبات مُحْرِجَة، وضَغْط سياسي على مستوى دولي.
ولما أصاب فيروس “WannaCry” أجهزة الكمبيوتر في 150 دولة سنة 2017م، وسَبَّبَ أضراراً تجاوزت 4 مليارات دولار، صار واضحاً للعالم أن الفدية الرقمية تكلّف أحياناً أكثر من القنابل الحقيقية.
خطورة الهجمات السيبرانية
اليوم، الاقتصاد العالمي مربوط بشبكات شديدة الحساسية: من البنوك المركزية، لشركات الطيران، من الطاقة النظيفة لمنصات النفط، ومن التأمين للمنظومات العسكرية. أيّ خلل بسيط في نقطة سيبرانية ممكن يَنْسِف أسواقاً كاملة. وما يُثير القلق أكثر، أنه لا يوجد بلد مُحصَّن، فمع أول أزمة تَحْدُث كوارث.
عندما تفشَّى فيروس كورونا في عام 2020، قفزت الهجمات السيبرانية بنسبة 600% بحسب بعض التقديرات. أغلب الوظائف تحوَّلت للعمل عن بُعْد، والأنظمة صارت مكشوفة أكثر.
لكنَّ الأخطر أنّ الهجمات السيبرانية أصبحت أداة ضمن أدوات “الحرب الاقتصادية”. ما في داعي لإعلان حرب، يكفي تَضْرب البِنْيَة الرقمية لبنك، تُسَرِّب بيانات، تُبطِّئ مصانع، أو تُعطِّل قمر صناعي…من خلال هذا الأمر، يمكن أن تكسر اقتصاد دولة كاملة دون أن تُطْلِق رصاصة.
توسُّع مفهوم الأمن القومي
ومع هذا التحوُّل، توسَّع مفهوم “الأمن القومي”، لم يَعُد فقط حماية الحدود، لكن أصبح يشمل حماية السحابة الرقمية، وكل معلومة متاحة على الإنترنت. كل شركة تكنولوجيا تحوَّلت لخطّ دفاعٍ، وكلُّ خبير أمنٍ سيبرانيّ أصبحَ بمقام جندي. دول مثل أمريكا، روسيا، الصين، وإيران، أسَّست جيوشاً إلكترونية حقيقية، فيها آلاف المبرمجين، ليسوا للدفاع فقط بل للهجوم أيضاً.
تخيَّل بلد صناعي، يتعطَّل فيه نظام الكهرباء، أو تتوقَّف فيه البورصة 3 ساعات على سبيل المثال. الخسائر ستكون بمليارات، والثقة بالنظام ستنهار سريعاً. العالم يتحرّك باتجاه اقتصاد رقمي شامل، والأمن السيبراني أصبح نقطة مركزية.
والمؤلم أكثر أن الدول النامية أضعف تقنياً، وبالتالي أكتر عُرْضَة للخطر، رغم أن الأذى لا يتوقف عند حدودها.
خسائر الحروب الإلكترونية
مشكلتنا اليوم ليست التطور التكنولوجي المذهل، ولكن هي عدم وجود قوانين واتفاقيات دولية تحكم هذه التقنيات وطرق استخدامها. لا يوجد حتى الآن اتفاق دولي واضح يَحْكُم الحرب الإلكترونية. لا توجد معاهدة جنيف أخرى تحمي مستشفى أو شبكة مياه من هجوم رقمي. وهذا الفراغ القانوني يجعل هذه الحرب الصامتة أخطر تهديد قادم.
الخسائر أصبحت مخيفة؛ في 2023، قُدِّرَت تكلفة الهجمات السيبرانية بأكثر من 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصولها لـ10.5 تريليون سنوياً في نهاية 2025، والمُفارَقَة أن ميزانيات الدفاع الإلكتروني لا تزال أقل بكثير من المفروض أن تكون عليه.
السؤال الحقيقي اليوم لم يعد يقتصر على “هل يوجد خطر إلكتروني؟”، بل: هل الاقتصاد العالمي فعلاً مستعدّ لهذا النوع الجديد من الحرب؟ لأنه في ظل التطوُّر اللحظي للتكنولوجيا، الجيوش والدبابات لا تكفي. أصبح لا بد من امتلاك مهندسين، مبرمجين، وجيل كامل من المُدرِّبين؛ وذلك للحماية من الهجمات السيبرانية.
خلاصة القول: الحرب القادمة يمكن ما نسمع صوتها. ولكنّ آثارها ستَصِل لكلّ مُواطن وستُؤثّر حتماً على كافة الخدمات، وستُهدِّد دولاً بالكامل دون استخدام آليَّات ومُدرَّعات وأسلحة مباشرة، وغير القادر على تأمين نفسه رقمياً سوف يكون الخاسر الأكبر في هذه المعركة.