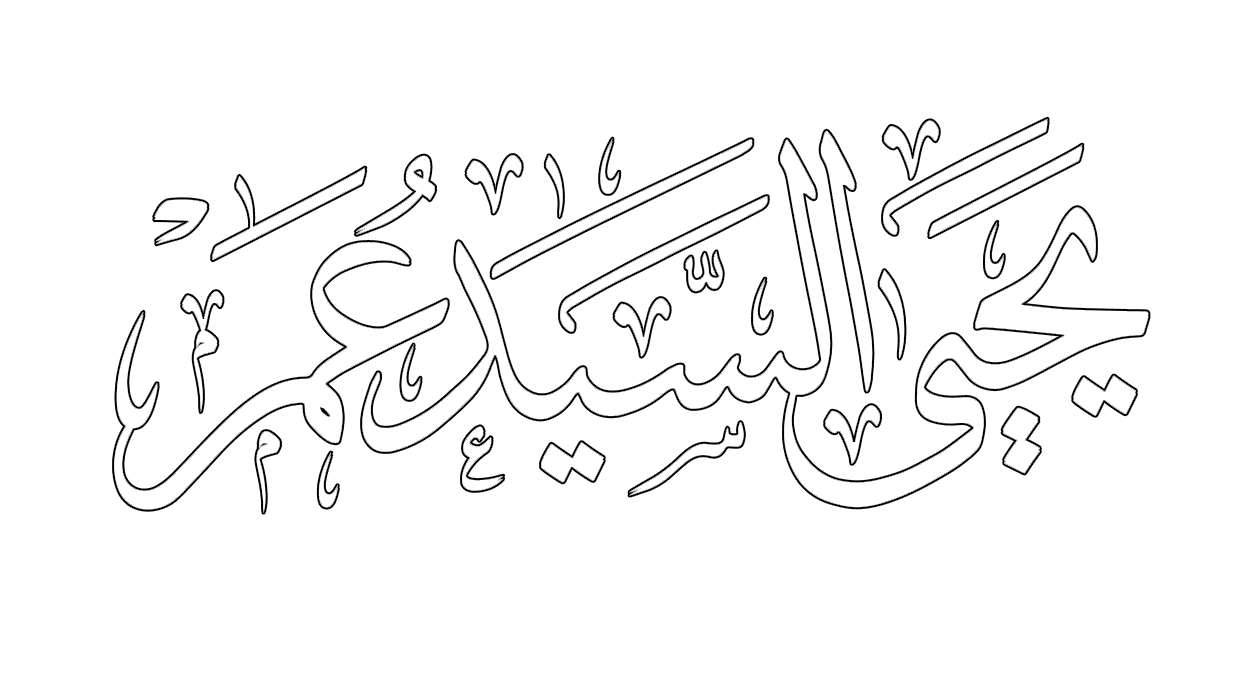
في عام 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، ولم يكن الاتحاد السوفييتي في البداية طرفًا فيها، على الرغم من التنافس الذي كان بينه وبين ألمانيا، إلا أن العداوة بقيت سرية ولم تخرج للعلن، والمفارقة أن موسكو كانت في بداية الحرب تُزوّد برلين بالحديد اللازم لصناعة السلاح، وألمانيا كانت تحارب فرنسا وبريطانيا أعداء الاتحاد السوفييتي، وهذا يعني أنه رغم العداء كانت توجد مصالح مشتركة بينهما.
لكن في عام 1941 قرَّر هتلر غزو موسكو، وتحوَّل العداء السّرّي إلى حرب طاحنة، وهنا توقَّفت المصالح، وبدأت صفحة جديدة من الحرب انتهت بخسارة ألمانيا بعد عدة سنوات.
عمليًّا لو اكتفى هتلر بالعداء السري ربما كان مسار الحرب قد تغيَّر بالكامل، وكان استمر تدفُّق الموادّ الأولية من موسكو، ويمكن كان شكل العالم اليوم مختلفًا بالكامل.
بداية العلاقة الاقتصادية بين أمريكا والصين
قصة ألمانيا والاتحاد السوفييتي اليوم تتكرَّر بين أمريكا والصين، بعد عام 2000 تحوَّلت الصين إلى قوة اقتصادية صاعدة، وبدأ الخليط من التنافس وتبادل المصالح بين أمريكا والصين.
العلاقة الاقتصادية دخلت مرحلة من التطور. أمريكا فتحت الأسواق أمام السلع الرخيصة القادمة من المصانع الصينية، وهذا الأمر استفاد منه المُواطن الأمريكي، وصار يشتري هواتف وأجهزة وأثاثًا بأسعار أقل.
في المقابل، الصين ساعدت أمريكا في تمويل العجز الحكومي، من خلال شراء سندات الخزانة، وهنا يمكن وصف هذه العلاقة بــ”زواج مصالح”.
العلاقة كانت معقّدة؛ عداوة غير مُعلَنة، وتعاون علني في بعض المجالات، وهذا بدأ يظهر بشكل واضح في الأزمة المالية العالمية عام 2008، فحينها كانت أمريكا بحاجة لأموال ضخمة لإنعاش الاقتصاد.
سياسة المال السهل
هنا ظهر مصطلح المال السهل، والذي يعني وجود قروض بفائدة قريبة من الصفر، بهدف تحفيز الاقتصاد والخروج من الكساد، وطبعت واشنطن كميات كبيرة من الدولار، لكنّ الكمية لم تكن كافية، والحلّ كان يتمثل في طرح أذونات خزينة جديدة للبيع، وهنا دخلت الصين واشترت بمليارات الدولارات.
هذا الشراء ليس حبًّا في أمريكا، ولكنّ لأن انهيار الاقتصاد الأمريكي يعني خسارة بكين لسوق مُهِمّ، وفي نفس الوقت استفادت الصين من امتلاك سندات الخزينة الأمريكية لاستخدامها سياسيًّا، وهنا نرى كيف تتغلَّب المصالح على العداوة.
سياسة المال السهل عزَّزت من سيطرة الدولار، وكفّة القوة كانت في صالح أمريكا بشكل واضح، وهذا ما أشار له كريستوفر ليونارد Christopher Leonard في كتابه The Lords of Easy Money “سياسة المال السهل”، فقال: “إن هذه السياسة ساهمت في زيادة السيطرة الأمريكية على النظام المالي العالمي”.
سلاح أمريكا الأقوى والرد الصيني
الدولار كان سلاح أمريكا الأقوى، لذلك بدأت الصين تبحث عن سلاح جديد؛ تمثَّل هذا السلاح في مبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع عملاق يربط قارات العالم بشبكة هائلة من الطرق التجارية. فإذا كانت أمريكا تتحكّم في العالم بالدولار، فالصين ستتحكم به من خلال التجارة، وهنا بدأ التنافس يزداد، لكن لم يَصِل لمرحلة الصدام؛ فقد بقيت المصالح المشتركة تحكم الموقف.
الأمر كان معقّدًا جدًّا؛ حيث توجد شبكة مُعقَّدة من المصالح ومن التنافس؛ فالصين تحتاج إلى الدولار حتى تُموِّل مشروع الحزام والطريق، وأمريكا تحتاج إلى الصين لكي تشتري سندات الخزينة حتى تُموِّل الموازنة، وهنا أصبحت القضية أشبه بلُعْبَة شدّ الحبل، كل طرف يحاول أن يتخلَّى عن الثاني.
حرب العملات
في خطوة مختلفة انتقل التنافس لمرحلة جديدة، هي حرب العملات؛ فأمريكا تتّهم الصين بأنها تُخفِّض قيمة اليوان، بهدف سهولة التصدير وإغراق السوق الأمريكية بالبضائع الصينية. في المقابل تتَّهم بكين واشنطن بطباعة كميات كبيرة من الدولار، وهذا يرفع التضخم عالميًّا ويؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الصينية المُقوَّمة بالدولار.
حول هذه الفكرة يقول ليونارد Leonard: “إن السياسات النقدية الأمريكية، وتحديدًا سعر الفائدة، لم تكن ضد الصين، بل كانت قضية داخلية، بهدف تحفيز الاقتصاد، لكنْ يبدو أن الصين تأثَّرت سلبًا بهذه السياسة. لكن رغم كلّ هذه التوترات بقي الأمر تحت السيطرة، والسبب قناعة الطرفين أن الصراع التجاري المباشر لن يكون في مصلحة أحد”.
تحوُّل التنافُس إلى صراع مباشر
لكن كل هذا انقلب بعد وصول ترامب للبيت الأبيض في ولايته الأولى؛ فسلوكه كان يشبه سلوك هتلر مع الاتحاد السوفييتي؛ حيث حوَّل التنافس إلى صراع مباشر، وتحوّل الأمر من مصالح متبادلة مع عداوة غير مُعلَنة إلى معركة كسر عظام.
ترامب غيَّر كل قواعد اللعبة، وبدأ بفرض رسوم جمركية ضد منتجات الصين، وتأثرت بكين، وكذلك تأثرت أمريكا. فقامت الصين بفرض رسوم مماثلة، وخفَّضت قيمة اليوان لأدنى قيمة منذ عام 2007، وعمليًّا خفَّفت من أثر الرسوم وصارت البضائع الصينية أرخص. وهذا يعني أن الخسارة الصينية من الرسوم عوَّضتها المكاسب من خفض اليوان.
في المقابل الأضرار في أمريكا كانت كبيرة، ارتفعت الأسعار، وخسر المستهلك الأمريكي خلال عامين 51 مليار دولار، كما توقَّف تصدير بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا، واضطرت الحكومة الأمريكية إلى تقديم دعم للمزارعين بقيمة 28 مليار دولار لتعويض الخسائر.
والنتيجة النهائية لم تكن في صالح واشنطن، فالأمر كان أشبه بعملاقين يتصارعان، ولا يمكن لأيّ طرف فيهما أن يهزم الثاني بالضربة القاضية، غير أن هذا الصراع تسبَّب بضرر للاقتصاد العالمي بالكامل. ففي حروب الكبار الأقوى هو الذي يتحمَّل أكثر، والأمر أشبه بعضّ الأصابع.
أسلحة اقتصادية جديدة
في ولاية ترامب الثانية عاد الصراع من جديد، لكنْ هذه المرة بشكل أكبر وأخطر؛ بدءًا من فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، بالتزامن مع دخول أسلحة اقتصادية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمعادن الأرضية النادرة.
ترامب يُصِرّ على هزيمة بكين بالضربة الاقتصادية القاضية، وهذا غير ممكن، فالاقتصاد الصيني عملاق، وعنده شبكة هائلة من العلاقات. بالتأكيد الضغوط الأمريكية تُسبِّب ضررًا لبكين، لكنّ الضرر مُتبادَل، والإصرار على هزيمة الخصم يمكن أن ينتهي بخراب العالم.
التاريخ يقول: إن الحروب العسكرية تُولَد مِن رَحِم الاقتصاد؛ فالاقتصاد هو المُحرِّك الأهم للصراعات العسكرية، والوضع الحالي أخطر من مرحلة الحرب الباردة، في ذلك الوقت كان مجال الصراع محدودًا في سباق تسلُّح، أما اليوم فكل الاحتمالات مفتوحة.
ترامب يُصِرّ على القضاء التامّ على كل الخصوم، وهذا يُذَكِّر مرةً أخرى بالسياسة التي اعتمدها هتلر، وحارَب العالم كله في الشرق والغرب، وانتهى الأمر بالهزيمة والفشل.
خلاصة الأمر: الصراع الأمريكي الصيني قد ينتهي بأزمة عالمية، لن تبقى محصورة بميدان الاقتصاد، بل يمكن أن تَجُرّ العالم لحرب عسكرية مفتوحة، الكلّ فيها خسران، ويمكن لأمريكا التي تُشْعِل هذه الحرب أن تكون أول وأكبر الخاسرين.