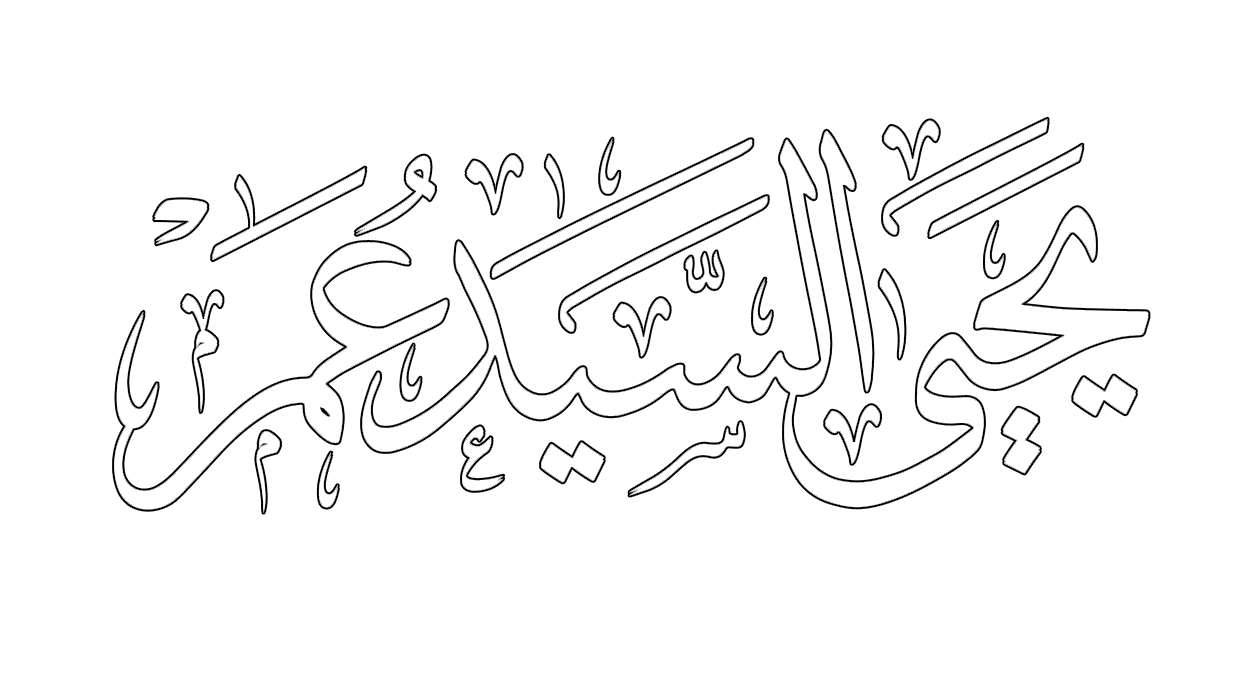
في عالمٍ يتغيَّر بسرعة، تبدو الأحداث الدولية وكأنها تفاصيل مُتفرّقة يَصْعُب فَهْم العلاقة بينها. من محاولات إحلال السلام في شرق أوروبا، إلى اضطرابات أسواق العملات الرقمية، مرورًا بتوترات تمتدّ من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يبدو المشهد بلا رابط واضح. لكنّ القراءة المتعمّقة تكشف عن حقيقةٍ أساسيةٍ لا يمكن تجاهُلها: سَعْي أمريكي قويّ لإعادة تأكيد نفوذها السياسي والاقتصادي على الساحة العالمية.
هذا الصراع ليس مجرد ردّ فِعْل مُؤقَّت على تحديات عابرة، بل محاولة من الولايات المتحدة للحفاظ على دورها الدولي في عالمٍ بدأت فيه القوة تتوزَّع بين أكثر من محور.
بعد سنواتٍ كانت فيها اللاعب الأكثر تأثيرًا، تجد واشنطن اليوم أنها مضطرة لاستخدام مختلف الوسائل -من الدبلوماسية إلى الضغط الاقتصادي، إضافة إلى أدوات القوة الأخرى-، للتكيُّف مع واقع عالمي يتغيَّر، ويجعل السيطرة المنفردة أصعب.
هذا الصراع يظهر في محاولات الولايات المتحدة لدفع الدول نحو طريقتها في إدارة الأمور، أو في ابتعادها أحيانًا عن بعض المنظمات الدولية، أو في تدخُّلها في الصراعات الإقليمية بما يخدم مصالحها. وفي النهاية، إنها محاولة لإعادة تعريف قواعد اللعبة العالمية، والرهان هنا هو على مستقبل النظام الدولي برُمّته.
مبادرات متضاربة بشأن الحرب في أوكرانيا
على صعيد الشرق الأوروبي، يظهر هذا الصراع بوضوح في المبادرات المتضاربة بشأن الحرب في أوكرانيا، تُعدّ هذه المبادَرات دليلًا واضحًا على أنّ صراع النفوذ الأمريكي لا يقتصر على الخصوم، بل يمتدّ إلى الحلفاء، وفي قلب هذا الصراع تقف روسيا كطرفٍ فاعِل لا يمكن تجاهُله. استمرار الحرب يخدم مصالح روسيا في إضعاف الغرب، بينما تسعى واشنطن لإنهاء الصراع بشروطٍ تضمن لها اليد العليا في ترتيبات الأمن الأوروبي المستقبلية.
عندما طرحت واشنطن خطة سلام تتضمَّن شروطًا صعبة على “كييف”، كان الهدف المُعلَن هو إنهاء الصراع، لكنّ الهدف غير المُعلَن هو أن تكون الولايات المتحدة وحدها القادرة على رسم خارطة طريق للسلام. هذه الخطة، التي تُوحي بضَغْط أمريكي لإنهاء الصراع وفق رؤيتها، أثارت قلقًا عميقًا في العواصم الأوروبية.
من زاوية موسكو، يرى بوتين أن أيّ خطة سلام لا تَعترف بالحقائق الجديدة على الأرض هي خطة غير واقعية. خطة بوتين تقوم على استنزاف الغرب، وإطالة أمد الصراع حتى تتغيَّر موازين القوى. وأيّ مبادرة سلام أمريكية أو أوروبية يجب أن تضمن عدم توسُّع الناتو شرقًا، وأن تَمنح روسيا اعترافًا ضمنيًّا بالمناطق التي سيطرت عليها. هذا الموقف الروسي يضع سقفًا عاليًا لأيّ مفاوضات، ويجعل من خطة السلام المقترحة مُجرّد أداة ضغط سياسي على “كييف” وحلفائها الأوروبيين.
بالانتقال إلى الدور الأمريكي الداخلي، يظهر تأثير ترامب، والذي يعتقد أنَّ الخطة قد تشمل تنازلات عن أراضٍ من جانب أوكرانيا مقابل وقف فوري للحرب، وهو ما يُثير قلقًا كبيرًا في كييف والعواصم الأوروبية. بالنسبة لترامب، إنهاء الحرب هدف يخدم رؤيته “أمريكا أولًا”، ويُخفّف العبء المالي عن واشنطن، حتى لو أدَّى ذلك إلى تأثيرات سياسية واسعة على أوروبا.
مجرد الإشارة إلى هذه الخطة يُشكِّل ضغطًا إضافيًّا من الولايات المتحدة على أوكرانيا وحلفائها، ويدفعهم إلى البحث عن حلول سريعة قبل أن تَفْرض واشنطن حلًّا قد يكون مؤلمًا.
الردّ الأوروبي لم يكن مجرد خلاف على تفاصيل صغيرة، الخطة الأمريكية قد تَضُرّ بمصالحهم طويلة الأمد، وتترك أوروبا في وَضْع أمني ضعيف أمام روسيا. أوروبا تسعى لأخذ زمام المبادرة من واشنطن، وهو ما يُضْعِف قدرة أمريكا على توحيد الصف الغربي.
مع سَعْي أوروبا لتقليص اعتمادها على واشنطن، يظهر هذا الخلاف بوضوح داخل حلف الناتو نفسه؛ لم يَعُد الحلف كتلةً واحدةً تَتْبَع توجيهات قائدٍ واحدٍ، بل تحالُف تتشابك فيه مصالح القوى المختلفة، وكل دولة تسعى لتعظيم مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب الرؤية الأمريكية.
هذا الصراع يُشكِّل تهديد لقُدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على نفوذها، ويدفع أوروبا إلى الاستقلال في اتخاذ القرارات لمواجهة تهديد روسيا.
غياب الولايات المتحدة عن قمة مجموعة العشرين
من الساحة الأمنية إلى المسرح الاقتصادي العالمي؛ كان غياب الولايات المتحدة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في جوهانسبرغ حدثًا مُهِمًّا بحدّ ذاته. هذا الغياب، يعكس إستراتيجية الإدارة الحالية في تفضيل العلاقات الثنائية على التجمعات مُتعدّدة الأطراف، وهنا يمكن أن يُنظَر إليه على أنه تراجُع محسوب بهدف تقليل أهمية هذه المنصات التي قد لا تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر.
عندما تبتعد واشنطن عن منصة حيوية تجمع القوى الاقتصادية الكبرى، يظهر فراغ يمكن أن تملأه قوى أخرى، وعلى رأسها الصين وروسيا ومجموعة “البريكس”. هذه الدول تمكَّنت من إصدار بيان ختامي يتناول قضايا المناخ والتحديات العالمية، رغم الاعتراضات الأمريكية المسبقة على بعض النقاط. هذا الإنجاز يُثْبِت أن العالم يمكن أن يتقدَّم ويتَّخذ قرارات مصيرية دون الحاجة إلى الدور الأمريكي.
الرسالة التي خرجت من قمة العشرين بغياب أمريكا هي أن النظام العالمي يتَّجه نحو تعدُّدية القوى عالميًّا، وأن إدارة القضايا الدولية لم تَعُد حكرًا على الغرب. هذا يُمثِّل تحديًا جوهريًّا للنفوذ الأمريكي، ويشير إلى أن أدوات الضغط الأمريكية التقليدية بدأت تَفْقد فعاليتها في المنتديات التي تتبنَّى مبدأ “صوت الجنوب العالمي”.
واشنطن، بمحاولتها تقليل دور هذه المنصات، تُخاطِر بعَزْل نفسها عن طاولة المفاوضات التي ترسم مستقبل الاقتصاد العالمي، مما يفتح الباب أمام منافسيها لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي.
أكثر المجالات سخونةً في صراع النفوذ العالمي
الجبهة الاقتصادية اليوم واحدة من أكثر المجالات سخونةً في صراع النفوذ العالمي، الأحداث الاقتصادية الأخيرة تُظْهر: كيف يتم استخدام البيانات ومؤشرات الطاقة وحركة التجارة العالمية كأدوات مباشرة لإعادة تشكيل النفوذ.
ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية يمنح واشنطن ورقة ضغط فعّالة؛ لأن فائض المعروض سوف يَكْبَح الأسعار، الأمر الذي يُخفّف التضخم المحلي، ويُضْعِف قدرة دول “أوبك بلس” -خصوصًا روسيا والسعودية-، على تمويل ميزانياتها. وهذا يُعزّز استقلال أمريكا على صعيد الطاقة، ويُوفّر لها مساحة أوسع للمناورة.
في المقابل، يكشف تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية عن نجاح نِسْبي للإستراتيجية الغربية القائمة على فك الارتباط وتقليل الاعتماد على بكين. كما أنَّ ضعف الطلب العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية يضغط على القطاع الصناعي الصيني، ويَحُدّ من قدرة بكين على توسيع نفوذها الاقتصادي.
هذه المؤشرات تُوضّح أن أدوات الضغط الاقتصادية أصبحت تُحقِّق تأثيرًا ملموسًا، وأن معركة النفوذ العالمية تُدار اليوم عبر البيانات والأسواق قبل الجيوش والسياسة.
طبعًا هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى تباطؤ الطلب من الأسواق الخارجية، وإلى الأعباء الإضافية التي فَرضتها سياسات الحماية الغربية، الشيء الذي أدَّى إلى تقلُّص قدرة المصانع الصينية على الحفاظ على مستويات إنتاج وربحية مرتفعة.
هذا الضعف يخدم الأهداف الأمريكية التي تسعى إلى “فك الارتباط” أو “تقليل المخاطر” مع الصين. فالتباطؤ الاقتصادي يضع قيودًا على قدرة بكين في توسيع نفوذها عالميًّا، ويَخْلق ضغوطًا داخلية قد تَدفعها إلى تهدئة التوترات التجارية مع الغرب لاستعادة نشاط الصادرات. هذا الحدث يظهر أن الضغط الاقتصادي الغربي بدأ يُؤتي ثماره في إبطاء نمو بكين.
الخلاصة هنا أن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية يَمنح واشنطن قوةً إضافيةً تُستخدَم للضغط على الخصوم والحلفاء، فيما يكشف تراجُع أرباح الشركات الصينية عن فعالية الضغوط الغربية في إبطاء نموّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم… هذه الأحداث تُؤكّد أن الاقتصاد هو الجبهة الأكثر سخونة في صراع النفوذ العالمي الحالي.
أزمة العملات الرقمية الأخيرة
من الاقتصاد، ننتقل إلى المجال المالي؛ صراعُ النفوذ الاقتصادي يظهر في أزمة العملات الرقمية الأخيرة. هذه العملات فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بالشكل الذي أثَّر على المستثمرين الأمريكيين والمؤسسات المالية التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
الولايات المتحدة كانت السَّبَّاقة في تبنّي العملات الرقمية، ما جعلها مركزًا للابتكار المالي، ولكنّه جعلها أيضًا الأكثر عُرْضَة لـ”فُقَّاعة” الأصول الرقمية. الخسائر التي وَاجَهَتْها المؤسسات الأمريكية تُثير تساؤلات حول استقرار النظام المالي الأمريكي، وبنفس الوقت ترفع من الضغط على الجهات التنظيمية الأمريكية.
في المقابل، أوروبا كانت أكثر حَذرًا في التعامُل مع العملات الرقمية؛ لأنها فَرَضت قيودًا تنظيمية مُشدَّدة نسبيًّا. هذا الحذر أصبح ميزةً اليوم. أوروبا تستطيع توجيه الأموال بعيدًا عن اضطرابات العملات الرقمية نحو القطاعات التقليدية والإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يمنحها فرصة لتحقيق نموّ اقتصادي ملموس في هذه المجالات، وبنفس الوقت تكون مستفيدة من انشغال الولايات المتحدة بالأزمات المالية.
هي إذن لحظة قد تُعيد التوازن الاقتصادي بين القارتين. بينما تنشغل واشنطن بإدارة تداعيات الأزمة المالية للعملات الرقمية، تسعى أوروبا لاستغلال هذا الاضطراب لتعزيز نُفوذها الاقتصادي الحقيقي والإنتاجي، والتحوُّل إلى مركزٍ ماليّ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات طويلة الأجل. وهذا يُمثِّل تحديًا كبيرًا لنفوذ الدولار الأمريكي على المدى الطويل؛ لأن القوى الاقتصادية الكبرى تبحث عن بدائل مالية مستقرة أكثر.
زيادة الضغط الأمريكي على فنزويلا
على الصعيد السياسي-العسكري، يظهر النفوذ الأمريكي في شكله التقليدي عبر زيادة الضغط على فنزويلا؛ من خلال إرسال حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” قُبَالة السواحل الفنزويلية، بالتزامن مع الحديث عن عمليات استخباراتية مُحتمَلة، هو رسالة واضحة من واشنطن تُفيد بأنّ منطقة نفوذها التقليدية في أمريكا اللاتينية لا تزال خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه.
هذا التصعيد، يأتي ضمن محاولات لتغيير النظام في كاراكاس، يهدف إلى تأكيد القوة العسكرية والسياسية الأمريكية في مواجهة أيّ محاولات من قوًى أخرى، مثل روسيا أو الصين، لزيادة نُفوذها في المنطقة. فنزويلا، الغنية بالنفط، تُمثِّل نقطة ارتكاز إستراتيجية في أمريكا اللاتينية، وأيّ نُفوذ صيني أو روسي فيها يُنْظَر إليه في واشنطن على أنه تَهديدٌ مباشِرٌ للأمن القومي الأمريكي.
استخدام القوة العسكرية في هذه الحالة يعكس تطبيقًا عمليًّا لـ”عقيدة مونرو”؛ حيث تَعْتبر واشنطن أمريكا اللاتينية منطقة نُفوذ تقليدية. هو استعراضٌ مُباشِر لأدوات القوة لتأكيد سيطرتها، وتذكيرٌ بأن نُفوذها لا يزال مدعومًا بقُدُرات عسكرية كبيرة.
هذا الضغط لا يقتصر على فنزويلا فقط، بل هو أيضًا رسالة تحذير مُوجَّهة إلى بكين وموسكو، تقول: إن واشنطن لن تسمح بأيّ محاولة للحدّ من نفوذها في مناطقها المهمة، حتى لو كان على حساب الاستقرار الإقليمي.
التدخُّل الأمريكي في التوتُّر بين الصين واليابان
أما في آسيا، المنطقة التي أصبحت مركزًا اقتصاديًّا وسياسيًّا مهمًّا، فيظهر صراع النفوذ الأمريكي في التوتُّر المتزايد بين الصين واليابان. تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الأخيرة حول احتمال التدخُّل العسكري في تايوان زادت التوتُّر مع بكين، ممَّا يُهدِّد بِجَرّ المنطقة إلى صراعٍ أوسع.
هنا، يظهر التدخُّل الأمريكي، عبر اتصال الرئيس ترامب بالزعيمين؛ كإستراتيجية مزدوجة شديدة التعقيد؛ تُؤكّد دور واشنطن كـ “ضَامِن” للاستقرار الإقليمي، ووسيط لا غِنَى عنه بين حلفائها وخصومها. فمن خلال وَضْع نفسها في موقع الوسيط، تضمن واشنطن أنّ أيّ حلّ للأزمة يجب أن يَمُرّ عَبْرها، ممّا يُعزّز من نفوذها الدبلوماسي.
وفي الوقت نفسه، استغلال هذا التوتُّر لتعزيز التحالفات الأمنية مع اليابان ضد النفوذ الصيني المتزايد. فمحاولة ترامب لحلّ الخلاف ليست عملًا إنسانيًّا، بل خطوة إستراتيجية تهدف إلى إدارة الصراع بطريقةٍ تَخْدم المصالح الأمريكية، وتضمن بقاء واشنطن هي القوة المحورية التي تُدير تغيُّرات القوة في أهم منطقة اقتصادية في العالم. هذا التدخُّل يُوضِّح أن الأمن في آسيا يعتمد على الحماية الأمريكية، ويُقلِّل من قدرة الصين على فَرْض نظام إقليمي جديد.
إستراتيجية أمريكية لتعزيز النُّفوذ
وفي الختام، هذه الأحداث التي تبدو مختلفة، تَرْسم صورةً واضحةً لإستراتيجيةٍ أمريكية مُتعدِّدة الجوانب لتعزيز نُفوذ الولايات المتحدة. فمن أوكرانيا؛ حيث تسعى واشنطن لفرض رؤيتها للسلام على حلفائها، إلى قمَّة العشرين؛ حيث تحاول التقليل من تأثير التعاون بين الدول، مرورًا بأزمة العملات الرقمية للاستفادة منها في تعزيز الرقابة المالية، وصولًا إلى استخدام القوة الصلبة في فنزويلا، وإدارة الصراع في آسيا. الاقتصاد هنا هو أداة صراع حيوية؛ فارتفاع مخزونات النفط يَمْنح واشنطن قوةً إضافيةً، بينما الضَّغْط على الصين يُبطِّئ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
في النهاية، مع كلّ هذه التحوُّلات، يبدو أن الاقتصاد لم يَعُد مجرد أرقام وإحصاءات، بل أصبح ساحة صراع بحدّ ذاته. ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي أعطَى واشنطن ورقةَ قُوَّة تستطيع بها الضَّغط على خصومها وحلفائها، بينما تراجُع أرباح الشركات الصينية يُذَكِّر الجميع بأنَّ الإستراتيجيات الاقتصادية الغربية بدأت تَتْرُك الأثر في تباطؤ النمو الصيني.
الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط على مدى قدرة أمريكا على فَرْض نفوذها، بل على كيفية استجابة العالم لهذا الواقع المُتغَيِّر؛ فهل ستنجح الولايات المتحدة في تعزيز مكانتها وسط تعدُّد القوى؟ أم أنّ الخصوم والحلفاء سيبحثون عن بدائل جديدة للنظام القائم؟
في هذا المشهد المتشابك، يبقى السؤال الأكبر: في عالَمٍ تتشابك فيه السياسة بالاقتصاد، ويصير كلُّ ملفٍ أداةَ صراعٍ، مَن سيكتب قواعد اللُّعبة القادمة؟ هذا هو السؤال الذي ستُجيب عنه الأيام القادمة.
قد تَكْمُن الإجابة في قُدرة واشنطن على المُوازَنة بين القوة والحوار، وبين العمل الفردي والتعاون الدولي. هذا الصراع على النفوذ سيُحدِّد مستقبل النظام العالمي خلال القرن الحادي والعشرين.