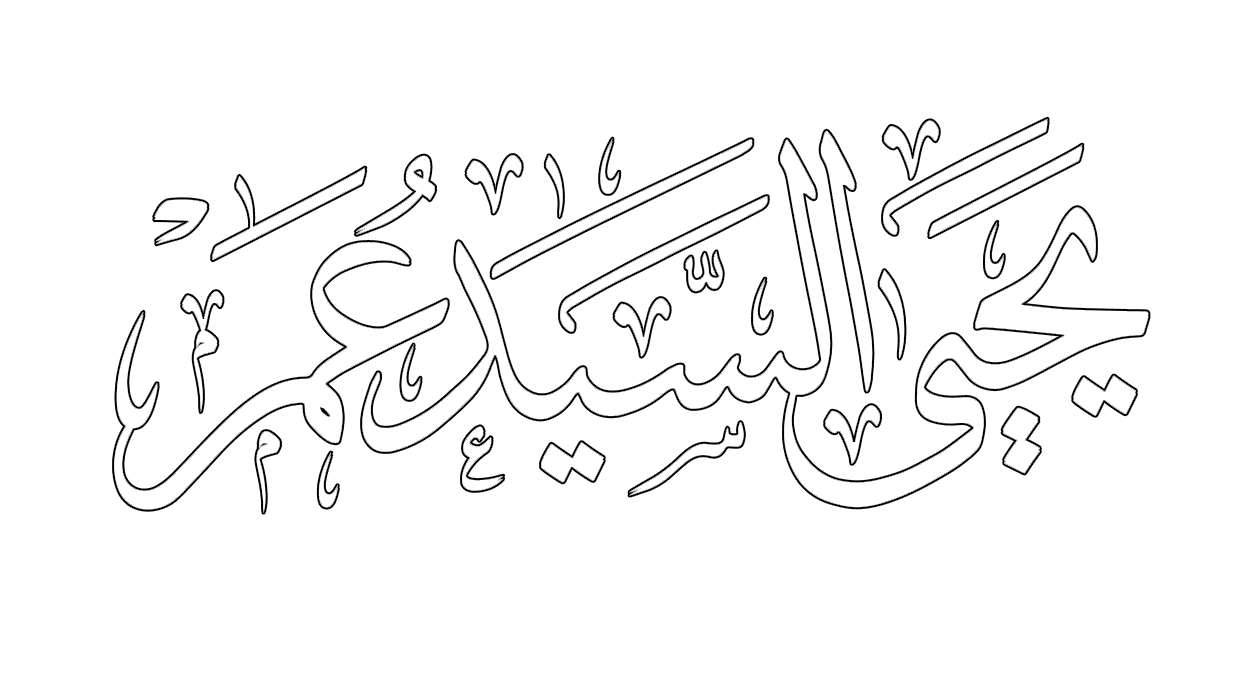
في القرن الحادي عشر الميلادي، بدأت الحملات الصليبية على المشرق العربي، تحت شعار استعادة بيت المقدس من المسلمين، وحماية مسيحيي الشرق من الاضطهاد، لكنّ الحقيقة كانت غير ذلك، فمسيحيو الشرق أنفسهم كانوا ضحايا لهذه الحملات، آلاف المسيحيين قُتِلُوا في أنطاكيا والقدس وغيرهما، ما يعني أن شعار الحملات كان ستارًا لأهداف أخرى غير معلنة.
الأهداف الحقيقية لهذه الحروب كانت في بعض جوانبها اقتصادية، وتهدف لتدمير موانئ المسلمين على البحر المتوسط، والتي كانت تُشكِّل منافسًا تجاريًّا قويًّا للموانئ الإيطالية، لذلك كان كبار تجار إيطاليا من أبرز مُموِّلي هذه الحروب.
مُبرّرات غير حقيقية للحروب
منذ فجر التاريخ وحتى الآن، لا يخلو العالم من الحروب، والتي تتم تحت شعارات عدة؛ دينية، عرقية، حقوق الإنسان، حماية الأقليات، وغيرها. لكن كلها مبررات غير حقيقية.
قبل عدة عقود ظهر مُبرِّر جديد للحروب، وهو صراع الحضارات، طرح الفكرة المفكر الأمريكي صموئيل هنتنجتون Samuel P. Huntington في كتابه “صدام الحضارات، وإعادة تشكيل النظام العالمي”، والذي صدر عام 1996م، وتُرْجِم إلى 39 لغةً، وعلى الرغم من مضي قرابة 30 عامًا على صدور الكتاب، فإنه لا يزال موضع اهتمام وجدل على مستوى العالم.
الصراعات الدولية في غالبيتها اقتصادية وإستراتيجية، وليست فكريةً أو أيديولوجيةً، لكن أحيانًا تسعى بعض الحكومات إلى تعزيز النزعات العرقية لتحقيق مصالح غير مُعلَنة، مثل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حينها تم الترويج للعِرْق الآري، وأنه متفوّق على الأعراق الأوروبية الأخرى، ما جعل الحرب تبدو كأنها صراع بين ثقافات، وهذا الأمر كان بهدف إيجاد دافع قتالي لدى الألمان، وتشجيعهم على الحرب، والدليل هنا أنه وبعد انتهاء الحرب تراجعت النزعة القومية عند الألمان بدرجة كبيرة.
الصراع الديني غطاء لصراعات اقتصادية
أينما وجدت الحرب وجد التنافس على الموارد الاقتصادية وعلى الموقع الإستراتيجي وممرات الطاقة، بينما أيّ دوافع أخرى غالبًا ما تكون غير حقيقية.
وهذا يناقض تمامًا ما قاله كتاب “صدام الحضارات”، والذي يُروّج كاتبه إلى أن الصراعات الجديدة ستكون بين الأديان. وتوجد عشرات الأدلة التي تؤكد أن الصراع الديني غالبًا ما يكون غطاءً لصراعات اقتصادية أو لتنافس إستراتيجي.
الصراع الأرميني الأذري مثال واضح، كانت الحرب بين أرمينيا المسيحية وأذربيجان الشيعية، لكن لم تكن الحرب أبدًا بين الأديان، بل كانت صراعًا إستراتيجيًّا، والدليل أن تركيا السُّنّية دعمت أذربيجان الشيعية، بينما إيران الشيعية دعمت أرمينيا المسيحية.
من جانب آخر، قد تبدو حماية الأقليات وبعض الجماعات الصغيرة مُبرِّرًا لبعض المواقف الدولية، وهي أيضًا محاولة لإخفاء مشاريع إستراتيجية. “ممر داود” على سبيل المثال، الذي تطرحه إسرائيل للربط بين السويداء في سوريا مع مناطق الأكراد، بهدف توفير الدعم الإنساني للدروز. هذا الطرح غطاء لمشروع كبير يهدف في الحقيقة لإضعاف تركيا، ويُمهِّد لنقل النفط العراقي عبر الحدود السورية مرورًا بالسويداء وانتهاءً بميناء حيفا، ما يجعل من إسرائيل مركزًا لتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط.
ما يحدث في السويداء يُعيد للأذهان أزمة الأماكن المقدسة التي حدثت في لبنان وسوريا عام 1860م، حينها هددت بعض الدول الأوروبية بالتدخل العسكري لحماية مسيحيي الشرق من الاضطهاد، لكنّ الهدف الحقيقي كان إضعاف الدولة العثمانية، وتأسيس قواعد عسكرية في المنطقة.
المشهد ذاته يتكرَّر، لكن مع تغيُّر اللاعبين، إسرائيل، عدا شعوب المنطقة، قلقة على مستقبل الدروز، هذا القلق حجّة للتدخل في سوريا وضمّ أراض جديدة، ولا علاقة له بأيّ حقوق أو أقليات.
ما فوق الطاولة شيء وما تحتها شيء آخر
في العلاقات الدولية ما فوق الطاولة شيء وما تحتها شيء آخر؛ فحقوق الإنسان، الحرية، الديمقراطية، حقوق الأقليات، العدالة، وغيرها من المفاهيم المثالية، غالبًا ما تكون ستارًا لنوايا استعمارية، مثل غزو أمريكا للعراق عام 2003م، فقد كان بهدف مُعلَن هو تدمير أسلحة الدمار الشامل التي لم يتم العثور عليها، وحماية العراقيين من القمع، والذي انتهى بمقتل أكثر من مليون عراقي.
كلّ هذه الشعارات كانت لإخفاء حقيقة واحدة، هي السيطرة على نفط العراق، والذي يملك 8% من الاحتياطي العالمي، ويحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم، وهذا تأكيد جديد على أن سبب الصراعات هو الموارد وليس الاختلاف الحضاري أو الثقافي.
الدوافع الحقيقية للتنافس الأمريكي الصيني
تبدو الهوية الثقافية عاملًا حاسمًا في الصراعات الدولية، ويتم الاستدلال على ذلك بالتنافس الأمريكي الصيني، ويقول في هذا الشأن كتاب “صدام الحضارات”: إن هذا الصراع نتيجة حتمية لاختلاف الحضارة والثقافة الصينية عن الأمريكية، لكن هذا الطرح غير دقيق، والتنافس الأمريكي الصيني لا علاقة له بالاختلاف الثقافي، وأمريكا أساسًا لا تُعدّ هويةً ثقافيةً واحدةً؛ لأن المجتمع الأمريكي غير متجانس لا عرقيًّا ولا ثقافيًّا، وهو خليط من الأفارقة والأوروبيين. والسبب الحقيقي لهذا التنافس هو الاقتصاد، والدليل على ذلك الرسوم الجمركية التي تهدف واشنطن من خلالها لعرقلة نمو بكين.
ممرات التجارة الدولية سبب رئيس للصراعات، وهنا يبدو التنافس بين المشروع الصيني العملاق “الحزام والطريق” مع المشروع الأمريكي لربط الهند بالخليج العربي وإسرائيل وانتهاءً بأوروبا، في هذا الصراع تدعم واشنطن نيودلهي وتتحالف معها ضد بكين، على الرغم من عدم وجود أيّ قواسم مشتركة بين الثقافة الأمريكية والهندية، فالتحالف هنا كان بسبب المصالح، وتنافس الهند والصين أيضًا بسبب المصالح، ولا علاقة للهوية الثقافية أو للحضارة، ما يُؤكّد مجددًا عدم دقّة نظرية صدام الحضارات.
خلاصة الأمر: الصراعات الدولية لا علاقة لها بالهوية والانتماء، بل تتعلق بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية، ونظرية صدام الحضارات لم تتمكن من تقديم تفسيرات حقيقية لأسباب النزاعات الدولية، بينما الاقتصاد السياسي نجح في تفسير الدوافع الفعلية للحروب، فعندما تُفرِّق الهوية والانتماء الدول يجمعها الاقتصاد.