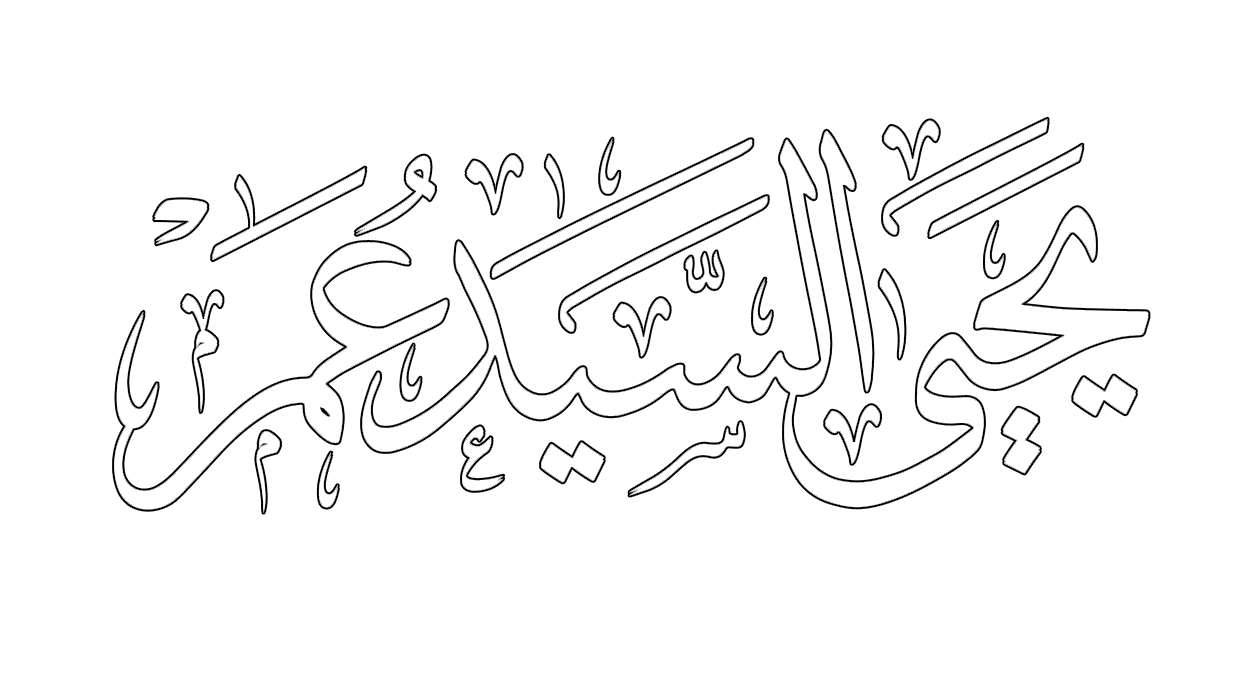
في فبراير 2002، وقع حادث في عربة قطار بمدينة Godhraغودهرا الهندية؛ نتج عنه مقتل 59 هندوسيًّا ماتوا محترقين، هذه الحادثة كانت بمثابة الشرارة التي تحوَّلت إلى جحيم ضد المسلمين في ولاية غوجارات؛ رغم أنه لم يثبت رسميًّا أنهم هم الذين دبَّروا الحادثة.
خلال أيام، احترقت أحياء بأكملها، قُتِلَ أكثر من 2,000 مسلم، وتحوَّل الجيران إلى جلادين. الشرطة وقفت تتفرج، وأحيانًا ساعدت القَتَلة. تم التعدي على النساء، والبيوت صارت رمادًا، وكل مسلم أصبح هدفًا مستباحًا.
وبقيت غوجارات جرحًا مفتوحًا في ضمير الهند، تُذكِّر بأنّ الطائفية ليست حادثًا عرضيًّا، بل هي وَحْش يسكن الدول، يستيقظ حين تضعف العدالة.
تحوُّل الطائفة إلى هوية سياسية
المفكر السوري برهان غليون يتناول هذه الفكرة في كتابه “المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات”، ويرى أن الطائفية ليست مرضًا دينيًّا، بل هي عَرَض سياسي واجتماعي، يظهر عندما تغيب دولة المواطنة، ويصبح الانتماء الديني أو العِرْقي هو أساس العلاقة بين الشعب والسلطة.
الفكرة تبدأ من الجذور التاريخية، من اللحظة التي تحوَّلت فيها الطائفة إلى هوية سياسية؛ عندما صارت الطائفة تعني الانتماء، وليس الإيمان، وأصبح الدين يُستعمَل درعًا للسلطة لا كقيمة روحية. من هنا وُلِدَت الصراعات التي لم تَنْتهِ؛ لأنّ كل جماعة رأت نفسها الأصل، والباقي هم التهديد.
الأقليات من مكوّن طبيعي إلى عبء سياسي
مع ظهور الدولة الحديثة، كانت المشكلة أعمق؛ لأن التنوع الاجتماعي في الدولة العربية لم يُحْدِث ذلك الفَرْق، بالعكس تعاملت معه على أنه أزمة، اعتمدت على فكرة الأمة المتجانسة، أمة بلون واحد، دين واحد، وصوت واحد. هنا تحوَّلت الأقليات من مكوّن طبيعي إلى عبء سياسي.
وهذا الشيء أوضح ما يكون في لبنان وسوريا والعراق، حكومات حاولت تبني وطنًا موحدًا، لكن دون عقد اجتماعي جامع، وصارت الطائفية هي البديل عن الوطن.
الطائفية ليست هوية، بل هي أداة سلطة؛ وعندما تضعف الدولة يصير الولاء للطائفة، وعندما يتراجع القانون يحل محله الانتماء المُغلَق. طبعًا النُّخَب السياسية تستغلّ هذا الانقسام حتى تُثْبِت وجودها، وبدل أن تعمل على توحيد الشعب، تقسمه حتى تسيطر عليه.
التجربة العراقية بعد 2003 مثال واضح؛ فالمحاصصة الطائفية لم تَبْنِ ديمقراطية، بل سلَّمت الدولة لميليشيات ترفع رايات المذهب بدل عَلَم الدولة.
في لبنان أيضًا، أصبحت الطائفية هي الهوية السياسية للدولة، وهي التي أعطت ميليشيا حزب الله مبررًا لتأسيس دولة داخل الدولة، لذلك يمكن اعتبار اتفاق الطائف عام 1989 هو الذي أطلق يد الميليشيات الطائفية في لبنان؛ لأنه اعتمد على الانتماء المذهبي في إدارة الدولة.
الأقليات أداة بيد الخارج
الأقليات التي يتم الحديث عن حمايتها، كانت أحيانًا أداة بيد الخارج. القوى الكبرى استخدمتها حجة للتدخُّل في شؤون الدول، وهذا كان واضحًا خلال أزمة عام 1860م في سوريا ولبنان، عندما حاولت فرنسا التدخل في شؤون الشرق العربي بهدف إضعاف الدولة العثمانية. والحجة كانت حماية الأقليات خاصةً الموارنة. السويداء اليوم مثال آخر، فإسرائيل اليوم تحاول التدخل في شؤون سوريا الداخلية من خلال استخدام ورقة الدروز.
حتى الاقتصاد، لم ينجُ من الانقسام الطائفي؛ فالبلدان التي تم تقسيمها طائفيًّا، أصبح توزيع الثروة فيها مرتبطًا بالهوية؛ المناصب والفرص وحتى القروض البنكية، تتم عبر شبكة الولاء الطائفي، وليس عبر الكفاءة. ومع الوقت، أصبح الفقير هو ابن الطائفة الفقيرة، والغني هو ابن الطائفة الغنية، وتحوَّل الاقتصاد إلى خريطة للتمييز.
الإعلام كذلك لعب دورًا كبيرًا في تفخيخ الطائفية؛ لأنّ الخطاب الطائفي لم ينتشر من فراغ؛ فالكلمة التي تُقال على الهواء أو تُكتب في الصحف، يمكن أن تُشْعِل نارًا بين الناس أكثر من أيّ رصاصة. وهنا نتأمل كيف يتم وصف “الآخر” في الإعلام، هذا ما يُحدِّد إذا كانت الناس ستتعاطف معه أو تكرهه.
وفي زمن السوشيال ميديا، صارت الطائفية رقمية، متخفية تحت شعارات الحرية والهوية، لكنّها تخلق جدرانًا جديدة بين البشر.
ومع العولمة، تغيَّر شكل الانتماء؛ فظهرت هويات رقمية، مجتمعات افتراضية، ومهاجرين يحملون أوطانهم على هواتفهم. وبدل أن تَضْعُف الطائفية، أصبحت تنتشر بأشكال جديدة؛ لأن المنصات التي تجمع الناس بدأت تفرزهم بنفس الوقت، وتُحوِّل الاختلاف إلى مادة للتفاعل وليس للفهم.
نماذج لدول تجاوزت الطائفية
في المقابل، هناك دول نجحت في تجاوز أزمات الطائفية. رواندا مثال حي، فبعد مجازر التسعينيات، أغلقت باب الثأر، وأعادت تعريف نفسها على أساس المواطنة.
جنوب إفريقيا كذلك بعد الفصل العنصري، بَنَتْ مجتمعًا متسامحًا؛ لأنه كان الخيار الوحيد للبقاء. بينما في العالم العربي، ما يزال الأمر عالقًا بين الخوف من الاختلاف والحنين إلى وحدة وهمية.
الطريق لتجاوز الطائفية
القانون الدولي ينص على احترام المساواة والتعايش السلمي، لكنّه حتى اليوم لم يُوفِّر توازنًا بين حق الأقليات بالخصوصية وحق الدولة بالسيادة؛ فأيّ تهديد مهما كان بسيطًا لأيّ أقلية طائفية يتحرَّك العالم ضدّه، لكن لا يتم الحديث عن حقّ الدولة في السيادة على الشعب والأرض.
وهذا كان واضحًا -على سبيل المثال لا الحصر- في الهجوم الذي نفَّذه فلول النظام البائد ضد قوات الجيش السوري في الساحل في آذار/ مارس 2025؛ حيث ارتفعت بعض الأصوات تطالب بحماية حقوق العلويين، لكن لم نسمع أيّ أصوات تتحدَّث عن حق الدولة في بَسْط السيطرة على كلّ الأرض، وهذا نوع من الازدواجية الدولية.
الطريق لتجاوز الطائفية لا يَمُرّ عبر محو الطوائف، ولا عبر فَرْض نسيج اجتماعي مُوحَّد بالقوة. وإنما هو تحوُّل أعمق يبدأ بإعادة تعريف معنى الانتماء. والمواطنة ليست مجرد بند دستوريّ أو رقة هوية تُكْتَب وتُنْسَى، وإنما المواطنة عَقْد أخلاقي يومي يُمارَس في المدارس، في المحاكم، في سوق العمل، وفي خطاب الإعلام. وهذا يعني قوانين تضمن حقوقًا متساوية، وأماكن تمثيل تفتح باب المشاركة الفعلية لكلّ مُكوّن، ونظام اقتصادي يُعيد توزيع الفُرَص بدل ما يُعيد إنتاج التمييز.
خلاصة الأمر: التجارب تؤكّد أن الاعتراف بالتنوّع الثقافي والديني لا يكفي؛ لأنه من دون عدالة فعلية في توزيع السلطة والفرص، يبقى الاعتراف مجرد شعار. والمساواة الحقيقية لا تتحقّق عندما نقول: “كل الطوائف متساوية”، بل من خلال الممارسة الفعلية.
إن الاعتراف بحقوق الأقليات ضروريّ على الدول، لكن على الأقليات أيضًا تأكيد أنّ الولاء للدولة وليس للخارج. وعليه، فإن معالجة مشكلة الطائفية ليست مسؤولية الحكومات فقط، بل مسؤولية الجميع، بما فيهم الأقليات.