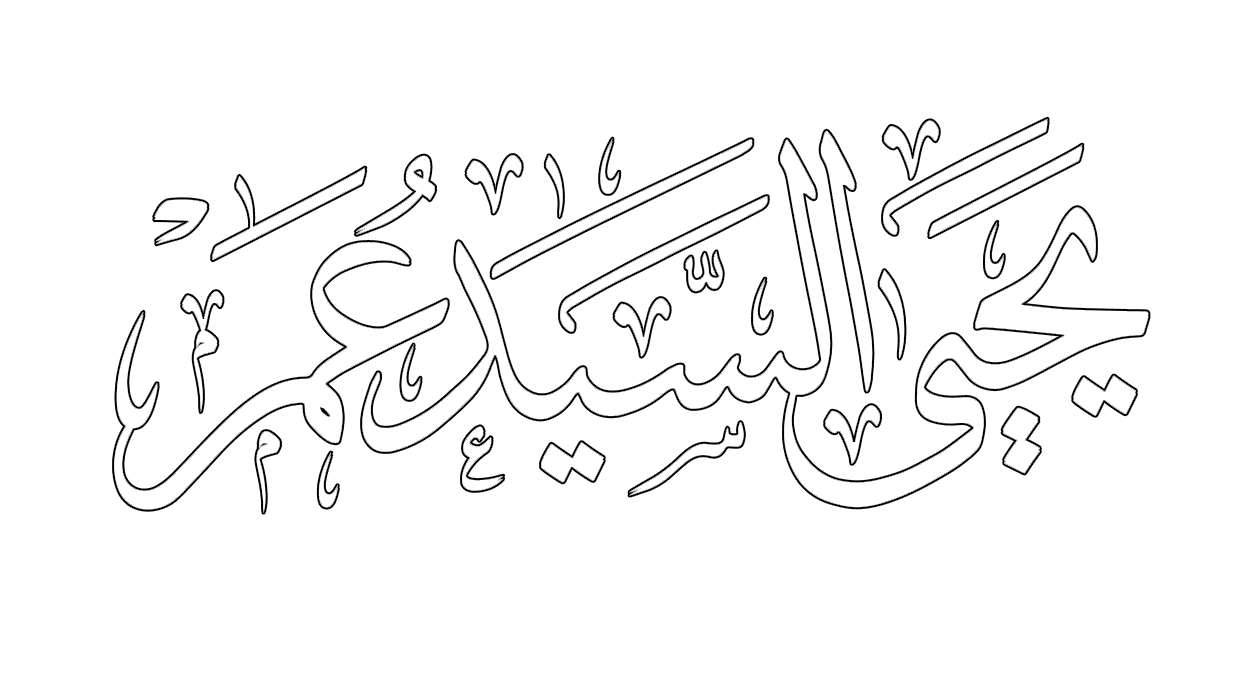
بصفة عامة لا تكاد تنتهي حادثة داعمة للتوتر الاجتماعي بين السوريين والأتراك حتى تطل حادثة أخرى. وهذا من شأنه تقويض كل المساعي الاجتماعية لتحقيق الاندماج الاجتماعي. ولعل آخر هذه الأحداث ما يعرف بحادثة “الموز” في تركيا. خصوصًا أنها أخذت من الاهتمام والتضخيم ما لا تستحقه. فما حقيقة هذه الحادثة؟ وما أثر التوتر الاجتماعي بين السوريين والأتراك؟
في الواقع قد لا يكون من المهم هنا العودة لتفاصيل حادثة “الموز”. فقد باتت أشهر من نار على علم. لأن جوهرها يقوم على أن جزءاً من الأتراك يرون أن السوريين في تركيا يعيشون بمستوى معيشي يفوق المستوى الذي يعيشه الأتراك.
تحديدًا تصاعدت القضية مع قيام سبعة سوريين بمشاركة مقاطع فيديو على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نوعاً من الاستفزاز للأتراك. نتيجة لذلك قامت السلطات التركية بالتحقيق مع هؤلاء. علاوة على ذلك ترشحت أنباء عن إصدار حكم قضائي بترحيلهم خارج تركيا.
من جهة أخرى لا شك أن أي حكم قضائي ضد هؤلاء الشبان يُعد مبرَّراً وعادلاً. إذ على الضيوف أن يحترموا قوانين مضيفيهم ويراعوا مشاعرهم. لكنَّ غير المبرَّر وغير العادل وغير الأخلاقي أن يُؤَاخذ ملايين الناس بجريرة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
في الحقيقة خضعت حادثة “الموز” لتضخيم هائل. لا سيما أنها تحولت لـ “ترند” بين السوريين. وهذا يعد أمراً غير صحيح بالمطلق. إذ إن الغالبية الساحقة من السوريين وخلال سنوات اللجوء الطويلة احترموا الدولة التركية ورموزها واحترموا قوانين البلاد ومشاعر وعادات سكانها.
في نفس الوقت إن القول بأن الأتراك والسوريين باتوا على طرفي نقيض اجتماعي يحمل في طياته مبالغة كبيرة وهي غير بريئة. فالعديد من الاستطلاعات تدل على أن غالبية الأتراك يرحبون ويتعاطفون مع السوريين. لكن دائماً ما يتم التركيز على الجوانب السلبية في هذه القضية.
في الوقت الحالي يُلاحظ أن العديد من أحزاب المعارضة التركية تسعى لتضخيم الحادثة. وذلك للاستفادة منها سياسياً. خاصةً أن أي حادثة سلبية لدى السوريين يتم تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤوليتها. كما تسعى أحزاب المعارضة أيضاً لاستثمار هذه الحادثة في الانتخابات الرئاسية التركية القادمة.
من جهة أخرى فإن أي مجتمع مُعرَّض لهكذا حالات. فهي لا تُعدّ خرقاً حقيقياً للعرف الاجتماعي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحالات تتطلب مُعالَجة قائمة على الحكمة والوعي الاجتماعي. فاحتواؤها يعد قضيةً سهلةً وممكنةً.
علاوة على ذلك ففي ظل الفضاء الإلكتروني الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بإمكان أي شخص المساهمة بتأجيج أيّ حدث. حتى إن كان مقيماً في دولة أخرى. لهذا لا يُستبعد أن يكون للبعض من الخارج مصلحة في تأزيم العلاقة بين الأتراك والسوريين.
على عكس ذلك وقبل عدة عقود من الزمن كان المجتمع مضبوطاً مِن قِبَل جماعات مرجعية. فعند أي حادثة يتدخل الحكماء والعقلاء في الحي أو المدينة أو الدولة ويقومون بالحل. وهؤلاء الحكماء أهَّلتهم مكانتهم الاجتماعية للعب هذا الدور. إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت الجميع فضاءً يمكنهم من التدخل في أيّ قضية.
لهذا السبب فإن من سلبيات تطوُّر وسائل التواصل التكنولوجي أنها قوَّضت إمكانية تدخُّل العقلاء في أيّ مشكلة. وفتحت الباب أمام بعض الجهلة وهو ما يسبّب تصاعد أيّ مشكلة. لأن أي مجتمع لا يحكمه عقلاؤه نهايته الفشل. نتيجة لذلك فلا سبيل للاستقرار في حال كان جهلة القوم يتصدّرون المشهد.
على أي حال إنَّ إعادة حادثة الموز لجذورها الحقيقية يقودنا للقول بأنَّ للضغوط الاقتصادية اليد الطولى في هذه الحادثة. لا سيما أن جزءًا من الأتراك يعتقدون أنهم يعانون أزمة اقتصادية لا يعاني منها السوريون. وهذا الأمر خاطئ بالمطلق.
وفي الوقت نفسه تزامنت حادثة “الموز” مع تراجع حاد في قيمة الليرة التركية. وهو ما فاقم من الضغوط الاقتصادية على الأتراك. لكن هذه الضغوط ليست محصورة بالأتراك فقط بل يتأثر بها السوريون أيضاً. كما أن التسويق لكون السوريين أحد أسباب الضغوط الاقتصادية في تركيا خاطئ أيضاً. فلولا السوريون لكانت هذه الضغوط أقسى.
زيادة على ذلك فقد أظهرت حادثة “الموز” أن لبعض الأتراك قناعات تقول بأن السوريين يعيشون في بحبوحة اقتصادية. وهذا الأمر خاطئ هو الآخر. فقسم كبير من السوريين في تركيا في عداد الطبقة المتوسطة. ناهيك عن وجود نسبة فقر مرتفعة بينهم. وهذا يقودنا لضرورة تحديد الأسباب الكامنة وراء انتشار معلومات مغلوطة حول واقع السوريين.
في نهاية المطاف تثبت حادثة “الموز” وغيرها من الحوادث ضرورة وجود قنوات اجتماعية تركية سورية تسعى لرأب أيّ صدع. وضرورة وجود نخبة اجتماعية حكيمة تضطلع بحل أيّ إشكالية وإلا فإن التوتر الاجتماعي سيبقى سيد الموقف.